-
 مدينة الخنادق
مدينة الخنادق
كأن الناس من شمع، الملامح بلا ملامح، النظرات باردة خاوية، والعيون بلا تعبير، كعيون السمك، وعابرو الطرق يمشون مشية ميكانيكية، أشياءً تتحرك.
لا أحد يعيرنى انتباهًا، وما من عابر طريق، يمنحنى محض التفاتة، كأنما صرت هواءً لا يُرى.
أميتٌ أنا أم هم الموتى؟.. شرعت أحادث نفسى تلك الليلة من خريف عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
كانت طائرة الشحن قد حطت على مدرج مطار العاصمة الألبانية "تيرانا"، بعد سبع ساعات من مغادرة أبوظبى، وكنت خلالها محشورًا فى جبال من المساعدات الإنسانية، لا أكاد أتمكن من تحريك يدى إلى شفتى لتدخين سيجارة، ذلك لما ابتعثتنى جريدة "البيان" لتغطية حرب تحرير كوسوفا، وأخبار معسكر الإمارات للاجئين على الحدود الصربية الألبانية.
ولمّا كنت منهك القوى، ارتأيت أن أبيت فى فندق ما فأستريح، حتى تقلنى "الهليوكوبتر" صباحا، إلى المعسكر فأبدأ مهمتى، وكنت فى الوقت ذاته أطمح إلى أمسية أوربية، فأشاهد عرضا مسرحيًا، أو أسهر فى مقهى، بصحبة حسناء ذات عينين زرقاوين، تشاطر غريبًا العشاء والثرثرة، على ضوء شموع وأنغام بيانو، أو "أتصعلك" فى الشوارع، "فأدردش" مع الذين لا أعرفهم ولا يعرفوننى، فأتآلف مع المكان.
نزلت فندقًا قيل لى إنه من أفضل الفنادق، فطلبت قهوة تركية، أول ما دخلت الغرفة، فأجابنى موظف خدمة النزلاء: "نصنع الاسبريسو"، فطلبت فنجانًا فقال: "ماكينة القهوة معطلة"، فسألت شايًا فأجاب: لدينا "ويسكى" إن شئت.. كظمت غيظى، ثم صرفته فبدّلت ملابسى وخرجت.
هل تعرف مطعما قريبا؟ سألت بالإنجليزية مراهقًا يرتدى الجينز، فمطّ شفتيه، وكررت السؤال مرات على آخرين وآخرين، دونما استجابة.
الوقت يمر.. والجوع يصرخ هستيريًا، كطفل يُنتزع من حضن أبويه.
الساعة العاشرة ليلا، والشوارع خاوية إلا من حانات حقيرة، أشبه ما تكون "بالخمّارات" فى أفلام "الأبيض والأسود"، والسكارى شربوا حتى الثمالة، الجميع يترنحون ذات يمين وشمال، ولسان حالهم يردد شعر أبى النوّاس: داونى بالتى كانت هى الداء.
ثمة "مخبز" له زجاج مغبر، دلفت مسرعا، إن رغيفًا ساخنا، قد يجدى نفعا، أصبحت لا أطمح إلى حسناء ولا شموع ولا بيانو.. طعام يسد الرمق فحسب.
فى زاوية من "المخبز" تقتعد شقراء بدينة فى منتصف الأربعينيات تحقيقًا، كرسيًا خشبيا، وأمامها زجاجة خمر يبدو رخيصًا، وبين يديها لفافة تبغ، تعبّ الدخان بنهم، عيناها كسولتان، وفوقهما شحمة متهدلة، لم تتحمس لمقدمى على الأرجح.
لا يوجد خبز.. وإنما حلوى ما، تحت غطاء من "النايلون" الشفاف.. رفعته المرأة بكسل، فحلقت أسراب من حشرات طائرة، فتراجعتُ فأمطرتنى بطلاسم، أوحت نبرتها الحادة بأنها نوع "ممتاز من الشتائم"!
إنى أخرج جائعا لأقطع الشوارع المظلمة الملتوية كأفعى أفريقية، أتحرك بقوة "قصور اليأس الذاتى"، لكن أملا لاح إذ أبصرت بائع شاورما عراقيًا، يحتل زاوية من ميدان كبير.
عربى وشاورما، ذو قربى وطعام مألوف.
سددت نحو سبعة دولارات، ومع أول قضمة شعرت بأن شيئا من المخلفات البترولية بين أسنانى.. لكأنى أمضغ "شبشبًا" عليه توابل ثقيلة لإخفاء حقيقته!
سأتناوله منشغلا عن رداءته بالحديث إلى العراقى، فالغريب للغريب قريب.
وشرع العراقى يفسر الأمور بلهجة بلاده الحزينة قائلا: إن ألبانيا ليست تنتمى إلى القارة الأوربية إلا جغرافيا، فقد حكمها الديكتاتور أنور خوجه، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى مات سنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين.
الرجل كان ظلاميًا، منع تعليم اللغات الأجنبية والمسرح والسينما، وسيطر على الإعلام، فأشاع خرافة أن أوربا تريد احتلاله، والظاهر أنه صدق الخرافة، فأخذ يحفر الخنادق، لا المصانع والمكتبات والمدارس، ولم يعد أمام النخبة المثقفة إلا الهجرة.
وبعد رحيل الديكتاتور بثمانية أعوام، كان الفقر أحكم قبضتيه على الشعب الجاهل، فاندلع الغضب بربريًا، وحطم الجوعى كل تماثيل خوجه، وتسولت البلاد اللقمة من الغرب، فما من صناعة أو زراعة أو علماء أو مفكرين، ما من شىء إلا أربعة أنواع من الخنادق، تحت مستوى سطح الأرض، وفوق الأرض، ونصف سطحية، ومتعرجة لها دهاليز للهروب.
واختتم العراقى الحزين كلامه بقوله: "صدام يفعل الشىء ذاته بالعراق".. ولم يكن هو ولا أنا نتوقع وقتئذٍ، أن تماثيل صدام ستتحطم بدورها، بعد أربع سنوات فحسب!
منقول من ياهو مكتوب
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة المهندسة في المنتدى منتدى العشائر والقبائل العربية
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 09-25-2022, 08:30 AM
-
بواسطة انور السعدي في المنتدى منتدى التاريخ العراقي لمختلف العصور
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 05-24-2022, 09:57 AM
-
بواسطة علي الحميدي في المنتدى منتدى التواصل الأخوي
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 07-16-2020, 08:02 PM
-
بواسطة بسمة شوق في المنتدى منتدى الاثآر والسفر والسياحة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 10-12-2016, 11:10 PM
-
بواسطة الارشيف في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 03-10-2014, 04:31 PM
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
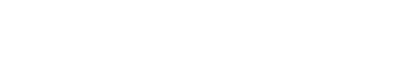








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات