-
 غوغائية الحكّام - نظامية الشعوب
غوغائية الحكّام - نظامية الشعوب
مقال كتبه صحفي (علي الساعدي) في جريدة المواطن ويستحق النقاش
وارجو ارائكم وتعليقاتكم القيمة ..مع كل تقديري وتحياتي
[gdwl]في رواية (شفرة دافنتشي ) لدان براون ، التي ووجهت بضجّة كبيرة من الأوساط الكنسية ، يذكر المؤلف ان الكثير من رموزالحضارت القديمة (الوثنية ) كما تسمى ، كانت تعبرّ عن معان أخرى غير ما رسمته الأديان لاحقاً، ويضرب مثلاً في أداة الصيد (الفالة ) ذات الرؤوس الثلاثة التي كانت من أسلحة بوسيدون إله البحار عند الإغريق، يردع فيها المخلوقات المؤذية ويطلق الرياح أو يوقفها إستجابة لنداء البحّارة والصيادين ، لكن الأديان قلبت ذلك الرمز فجعلته مرتبطاً بالشيطان.
تلك الإستخدامات المختلفة للرمز الواحد أو للمصطلحات الواحدة، لم تكن جديدة على بني البشر ، لكن الجديد فيها انها عادت الى مصدرها الأول وجوهرها الحقيقي .
كانت (الغوغائية) مصطلح يطلق على أولئك المنتفضين المهمشين والمضطهدين من حكامهم ، وقد أستخدمته السلطات بمعنى الحركات الفوضوية المتبّعة لغرائزها من غير تقدير للنتائج والعواقب، وهي غالباً ماتقوم بتدمير الممتلكات الخاصّة والعامّة وإشعال الحرائق والنهب والسلب ،مصحوباً بهستيريا جمعية ولغط مرتفع وصراخ غير مفهوم وسواه من الظواهر ، أي كلّ مايعني إخراج الإنسان من سويته وإدخاله من ثم في إضطراب عقلي وسلوكي ، يتطلّب تدخّل السلطات بقواتها القمعية لإعادة الأمن والنظام (في اللغة العربية ، قد توحي كلمة (غوغاء) بالغواية ، وهي مما يوسوس به الشيطان ) أي إن مايقوم به هؤلاء ضدّ حكامّهم ، يُعتبر رجس من عمل الشيطان ، حيث الحاكم واجب الطاعة في الأعراف الدينية والفتاوى الفقيهة لأنه يحكم بإرادة الله ولاتجوز مخالفته والا عدّ ذلك بمقام الكفر .
في فرنسا أيام لويس السادس عشر، أطلق على الثائرين وصفاً يقترب في مدلوله من ( الغوغاء) كما فعل نظام صدام حسين في إلصاق تلك الصفة بالمنتفضين في (الشعبانية ) ثم استخدم حسني مبارك المعنى ذاته وإن بلفظ مختلف ( الصيّع ) أي المشردين بلا مأوى والهائمين بلا هدف، وهو لايريد أن يدرك انهم (صيّع) بسبب نظام حكمه وغياب العدالة في توزيع الثروة الوطنية التي تركّزت بيد حفنة من الفئات المنتفعة ممن أطلق عليهم ( القطط السمان أو الحيتان بعد ازدياد ثرواتهم ) لكن زمن الثورات هذا ، قلب المعاني نحو مضمونها .
الفكر السياسي كما يُعرف، هو البوصلة التي يهتدي بها السياسيون ، ذلك لأن السياسة باعتبار قدرتها على إدارة الممكنات ، تفترض دائماً انها تتعامل مع متكافىء ، بمعنى ان جموع الناس ، هم أصحاب المصلحة الأولى في منتوج الفعل السياسي - كما يفترض - وان نجاح السياسي في أداء مهمته ، يتحدد في قدرته على إيجاد أفضل الوسائل وابتكار أنجع الأساليب التي تمكّنه من الفعل الصحيح .
ذلك هو الأصل في السياسة ، لكن الدكتاتوريات ، ولأنها لاتعتبر المجتمع مكافئاً لها ، بل في أمرتها ، فإنها لاتبحث عن إنتاج فكر سياسي تستطيع بواسطته مواجهة المشكلات ، سواء تلك الموجودة قبلاً ، أو المستجدّة في عهدها، أو الطارئة حدثاً ، التي تكون الدكتاتورية قد تسببت بها جرّاء ممارساتها .
على ذلك يمكن القول ان الحكم في الدكتاتوريات عموماً يقوم على مرتكزين : الولاء أو العداء ،ولأن الولاء يستجلب الطاعة المطلقة ويفرز مجموعة من السلوكيات الذاتية والسياسية ، منها إخفاء الحقائق أو تجميلها ، ومدح الحاكم درجة القداسة وذلك بحرف الوقائع لتطابق رؤيته لها وإسماعه مايرضيه ، لذا يداخله اليقين بفعل الصواب ويرى في أية حركة للتذمر او الإحتجاج ، تمرداً معادياً ومؤامرة يستحقّ أصحابها القتل ، ان الأمور عند الدكتاتورية دائماً بخير،حتى ربع الساعة الأخير . كانت الجيوش في خدمة الدكتاتوريات ، وبالتالي فهي السلاح الذي تستخدمه لتثبيت حكمها ، لكن ذلك السلاح لم يكن كافياً في معرفة (المتآمرين)وكشفهم في وقت مبكر، لذا وسّعت الأنظمة الدكتاتورية ، في إنشاء أجهزة المخابرات وتقويتها عدداً وعدة ، ومنحتها صلاحيات مطلقة ، تتيح لها العمل بقانون طوارىء دائم يخوّلها اقتحام البيوت واعتقال الأشخاص - بل وحتى قتلهم - من دون مذكرات قضائية أو محاضر رسمية أو ماشابه ، انها أجهزة تركبّ بطريقة لاضوابط في عملها ولاقيود تحدّ من صلاحياتها ، وهي ترتبط - بمعظمها- برأس النظام بشكل مباشر ، بل وخوّلت صلاحية التجسس على بعضها ، ماينشىء وضعاً خاصاً تكون نتيجته ان أفراد تلك الأجهزة يعيشون عقدة مرّكبة : الخوف من الناس بمقدار إخافتهم، والتعالي عليهم بحكم ارتباط رجال المخابرات برأس الحكم وعدم تعرضهم للمحاسبة ، ما يجعل ذواتهم تتضخم بشكل مفرط ، لشعورهم بأنهم مميزون ومختارون ، لتفوقهم الذاتي وأهميتهم للوطن - الوطن بنظرهم هو الدكتاتور - .
ذلك مايشكلّ مأزقاً حقيقياً عند رجل المخابرات ، إن حياته كفرد ، أصبحت مرتبطة عضوياً بالنظام وليس وظيفياً وحسب ، عكس رجال الجيش وبقية السلاسل الوظيفية الأخرى في الدولة ، التي ترتبط بكينونة الدولة بما هي دولة ، وبالتالي فانها في الغالب تقف عند نقطة وسطى بين الثورة والحاكم ، إنتظاراً لما ستكون عليه الغلبة ،فإن احتفظ الحاكم بمنصبه، حافظت ( الوظائف ) على مواقعها ، وان تغلبّ المنتفضون ، مالت الى جانبهم لتصل الى النتيجة ذاتها .
لكن أجهزة المخابرات لاتستطيع ان تكون على الحياد ، فهي تخشى ليس فقد وضعها المتفوق وحسب ، بل يرتفع لديها الخوف درجة الهستيريا ، لذا يتحولون كأفراد ، الى مهنة ليست جديدة بحدّ ذاتها ، لكن الجديد فيها طبيعة ممارستها ، فقد كانت تصرفاتهم محمية بالحاكم ، أما في زمن الثورة ، فيتحولون الى مليشيات تقتل بشراسة يدفعها الخوف على المصير بما فيه الفردي ، لينقلبوا من ثم الى (غوغاء ) أو بلطجية بلغة المصريين - نسبة الى البلطة أو الطبر - .
أولئك هم عماد النظم الدكتاتورية ، لكن ذلك لم يعد مجدياً ، فما يحدث الآن من ثورات ، تدخل في مرحلة التحولّ وليس الحدث ، والفارق بينهما، ان الحدث قد يكون منفصلاً أو مؤشراً أو مقدمات لما سيأتي ، وعلى ذلك ، يمكن للدكتاتورية إجهاضه بالقوة ، أو أن يتوقف بعد استنفاد أغراضه ،أما التحوّل ، فيأتي بعد مرحلة طويلة من التراكمات والإنضاج ومن ثم يظهر بمثابة تتويج وخلاصة لها.
، وعلى ذلك ، فإن التحوّل لابد ان يحدث تغييراً جذرياً يحمل ملامحه الخاصّة ، التي سرعان ما تبدأ الشروع في بناءات جديدة تختلف في أهم مفاصلها عمّا كان سائداً ، فالشرعية هنا ، تعود الى عامّة الناس وتنبثق من اختيارهم لا من إجبارهم ، وفيها تصبح القيادة وظيفة محددة ، لا حاكمية مطلقة وممتدّة ، أما الأجهزة الأمنية - والمخابراتية منها بشكل خاصّ- فتتغير مهمتها تبعاً لذك ، من حماية النظام الحاكم ، الى حماية النظام العام ، وبالتالي فهي وسيلة لجلب والمعلومات وجمعها وتصنيفها ، وليس أداة للقمع ، لذا تتحول الى وظيفة كغيرها من وظائف الدولة ، ولما كانت الديمقراطية تفرض سلفاً تغير السلطة حسبما يحدده الدستور ، فإن تلك الأجهزة لاتشعر بولائها للحاكم الفرد كما في النظم الدكتاتورية ،بل الى الدولة الجامعة ، ما يخلّصها من سلوكيات تحكمها عقدتي الخوف والتفوق كما أسلفنا .
ذلك ماظهر في الثورتين التونسية والمصرية ، فقد تحوّلت أجهزة القمع السرية ( المخابرات ) الى عصابات غوغائية مارست النهب والسلب والقتل وإشعال الحرائق ، فيما سارع المنتفضون الى تشكيل لجان شعبية حافظت الى الأملاك العامة والخاصة مؤكدة سلمية الثورة وقدرة الناس على الإنضباط الطوعي بعد ان تحرروا من الضبط القسري ، لقد كانوا واثقين من قدرتهم على إحداث التحوّل .
وهكذا جاءت الأزمنة لتثبت ان الإنتفاضات حينما تكون في طور الحدث - أي التعبير الغاضب عن تذمرها من حاكميها - فانها قد تلجأ الى أسلوب ( الغوغاء) يدفعها شعور مسبق بأن ماتقوم به ، هو بمثابة انتقام من الحاكم ، يجري التعبير عنه بتدمير أو نهب أملاك ليس للمنتفضين نصيب فيها ، ولايتوقعون حصولهم على موقع ، في دولة يمتلكها حاكم فرد وفئات منتفعة .
لكن ، عندما تدخل الثورة مرحلة النضج وبالتالي تنتفض الناس مصحوبة بشعور التحوّل ،فانها تتصاعد محرقة السلالم وراءها كي لاتعود الى النزول مرة أخرى ، من هنا تختلف الأساليب وطرائق التعبير عنها ، ففيما يبقي الحاكم على سلاحه الوحيد (القمع ) تظهر الشعوب قوتها في : ازدياد أعدادها من جهة ، وسلمية تحركها من جهة أخرى .
عامل جديد آخر دخل على واقع الثورات ،لقد لعب إنهيار الثورات الآيديلوجية التي أنتعشت أيام الإتحاد السوفييتي ،دوراً إيجابياً مؤثراً في بروز الثورات الجماهيرية بإسلوبها ( الغاندوي ) على حساب الثروات بإسلوبها ( الجيفاروي ).
بنظرة عامة أولية ، قد لانستبعد القول بان سقوط الإتحاد السوفييتي ، كان في جوهره بداية لسقوط الدكتاتوريات - بما فيها الثورية - وبالتالي فالشعوب ( المنتفضة اليوم ) التي طالما تربّت على إعتبار ( الإمبريالية الأمريكية ) عدوّها الأول ، هاهي تكسر حاجز الخوف من حكّامها ، إنطلاقها من الشعور بحماية دولية تتزعمها أمريكا ، وعلى رغم ان الكثير من ( الثوار) مازالوا يحتفظون بكمية من شعاراتهم السابقة بإعلان العداء لأمريكا ، الا انهم يدركون بأن الأنظمة تخشى المصير الذي لاقاه صدام حسين ، وبالتالي فهي لاتجرؤ على القيام بمذابح كما كانت تفعل ، أمّا ثورة الإتصالات ، فقد كانت بمّثابة ( الثورة الأمّ) التي ساهمت بحماية أبنائها المنتفضين[/gdwl]
منقول - وشكراا :((
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة عامر العمار في المنتدى منتدى الشخصيات الاسلامية
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 03-02-2019, 12:52 PM
-
بواسطة خالد الكعبي في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 04-16-2014, 08:41 AM
-
بواسطة حسام علي في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 03-02-2014, 04:41 AM
-
بواسطة حيدر المرعب في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-12-2014, 10:41 AM
-
بواسطة حيدر المرعب في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-10-2014, 11:41 AM
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
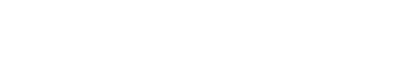








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات