-
 العنف مرشح للتصاعد في العراق مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي
العنف مرشح للتصاعد في العراق مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي
العنف مرشح للتصاعد في العراق مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي وبغداد ما زالت من اخطر مدن العالم
الأثنين يوليو 19 2010
 تصاعد العنف في العراق
لندن-
نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية تقريرا عن استمرار العنف في العراق قالت فيه إن هذا التقرير "يوضح الدرجة التي ما يزال هذا العنف استثنائيا.
ومن دون أن ينتبه العالم كثيرا فإن حوالي 160 عراقيا قتلوا، وجُرح المئات، خلال الأسبوعين الماضيين.
وما تزال الخسائر المدنية في الأرواح في العراق أعلى منها في أفغانستان، رغم أن أفغانستان أصبحت تحتل في الآونة الأخيرة اهتمام وسائل الإعلام.
لكن مقتل الدراجي يجب أن يتيح وقفة لأولئك الذين يتخيلون ما بعد مرحلة دخول الاحتلال الأميركي للعراق سنواته الأخيرة،
أو أن القوات المقاتلة الأميركية يمكن حتى أن تتباطأ في انهاء وجودها في العراق إلى ما بعد الموعد المقرر لرحيلها خلال ستة أسابيع تنتهي يوم 31 آب (اغسطس).
كما أن بقية القوات ستغادر في نهاية العام 2011وفقا لاتفاقية وضع القوات التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش عام 2008 خلال أيامه الاخيرة في البيت الأبيض.
وتضيف الصحيفة: "تترك القوات الأميركية وراءها بلدا هو حطام عائم تقريبا.
بغداد تبدو مدينة تحت احتلال عسكري، مع اختناقات مرورية مرعبة ناتجة عن 1500 حاجز تفتيش وشوارع مغلقة بأميال من الجدران الاسمنتية التي تخنق المواصلات داخل المدينة.
الوضع في العراق هو من نواح عديدة "أفضل" مما كان عليه،
لكن من الصعب أن يكون شيئا آخر،
إذا أخذنا في الاعتبار أن أعمال القتل في ذروتها عامي 2006و2007 كانت بمعدل 3،000 كل شهر.
وبعد التسليم بذلك، تبقى بغداد واحدة من اخطر المدن في العالم، أكثر خطرا للسير فيها من كابول أو قندهار.
ولا يمكن تحميل اللوم كله للقيادة السياتسية الحالية. فالعراق يتعافى من 30 عاما من الدكتاتورية، والحرب والعقوبات، والتعافي يسير بتثاقل وتناقص لأن تأثير الكوارث المضاعفة التي ضربت العراق بعد العام 1980 كان هائلا.
صدام حسين صبّ الأموال في الحرب التي شنها على ايران، ولم يترك شيئا للمستشفيات والمدارس.
والهزيمة أمام التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في الكويت أدى لانهيار العملة وإلى 13 عاما من العقوبات الدولية التي وصلت حد الحصار الاقتصادي.
ولم يتعاف العراق حتى الآن من هذه الكوارث. وعندما حاولت الأمم المتحدة ترتيب استبدال لقطع الغيار في محطات الكهرباء ومنشآت المياه في التسعينات قال الصانعون الاصليون إن المعدات كانت من القدم بحيث أن قطع الغيار بحيث لم تعد تُصنع.
خلال فترة العقوبات، لم يكن لدى الحكومة أموال فتوقفت عن دفع رواتب موظفيها، الذين صاروا يتقاضون أموالا لقاء خدماتهم.
أما هذه الأيام، فهم يتلقون رواتب جيدة لكن العهد السابق الذي لم يكن فيه أي عمل يتم دون رشوة لم يذهب إلى غير رجعة. مستويات الاشباع في الفساد أدت إلى خلل وظيفي.
ومثال صغير على ذلك: إحدى الصديقات التي تدرس في جامعة ببغداد حملت وطلبت إجازة وضع لمدة شهر هي من حقها.
مسؤولو الإدارة في الجامعة قالوا إن بإمكانها الحصول على الإجازة، ولكن بشرط أن تعطيهم راتب شهر الإجازة.
وما يجعل الفساد في العراق مدمرا هو عواقبه التي تشلّ جهاز الدولة وتحول دون أدائه مهامه الأساسية.
في العامين 2004و2005 مثلا سُرقت موازنة التجنيد العسكري البالغة 1،2 بليون جنيه استرليني بكاملها،
رغم أن ذلك ربما يُفسّر بالفوضى التي سادت خلال السنوات الاولى بعد عهد صدام حسين،
حيث كان الأميركيون يقومون بالكثير من الإجراءات ولم يكن أحد يملك أي صلاحيات حقيقية.
بعد خمس سنوات، من المعقول التفكير بأن التجنيد العسكري تحسن،
خصوصا في ما يتعلق بالقطع الاساسية من تجهيزات القوى الأمنية.
وفي هذا المجال ليست هناك أفضلية أكبر بالنسبة للحكومة من وقف المفجرين الانتحاريين من تنظيم "القاعدة" الذين يقودون سيارات محملة بالمتفجرات إلى وسط بغداد ويفجرون أنفسهم خارج الوزارات الحكومية، فيقتلون ويجرحون المئات من الناس.
العراقيون يتساءلون كثيرا عن السبب في تمكن المفجّرين من المرور دون ان يشتبه بهم أحد خلال حواجز عديدة.
خلال العام الماضين أصبح واضحا أن هناك سببا بسيطا إلى حد مذهل لذلك، يفسر الضعف الكبير لآلة الدولة العراقية.
الحقيقة غير الاعتيادية هي أن إبقاء المفجّرين خارج بغداد ، على الأقل،
يتعرقل لأن جهاز كشف القنابل الأهم الذي يستخدمه الجيش والشرطة للعثور على المتفجراتتبين أنه مزيف.
الحكومة دفعت اموالا طائلة للحصول على كاشف المتفجرات، الذي يسميه العراقيون "الصوتي"،
على الرغم أنه ياتي دون مصدر للطاقة- ومن المفترض أن يحصل على الطاقة من مشغّله،
الذي يفترض أن يحرك قدميه ليولد الطاقة الساكنة.
ورغم أن "الصوتي" بلا جدوى، فإن سوارا بلاستيكيا أسود مربوطا بعصا فضية تشبه هوائي التلفزيون في مقدمته،
يمثل الطريقة الأساسية التي يتم بها فحص المركبات المشبوهة في بغداد من جانب الجيش والشرطة.
وإذا كان فيها أسلحة أو متفجرات فإن السوار يشير إليها وهو يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها جهاز كشف المعادن.
المذهل في كاشف القنابل، المعروف رسميا بجهاز "أيه دي إي-651"،
هو أن الخبراء الحكوميين والصحف ومحطات التلفزة كشفوا مرارا عن عدم جدواه.
وكانت بريطانيا تنتجه اصلا، في مزرعة ابقار مهملة في مقاطعة سومرست، لكن المدير الإداري للشركة الصانعة اعتقل في المملكة المتحدة بتعمة التزييف وتقرر حظر تصدير الجهاز.
والمكون الإلكتروني الوحيد في الجهاز هو قرص صغير لا يزيد ثمنه عن بنسات قليلة، شبيه بالذي يلصق بالملابس في المحلات الراقية للحيلولة دون نشل الملابس والخروج بها دون دفع ثمنها.
وبالرغم من ان صنع كل "مجس" لا يكلف سوى نحو 50 دولاراً، فقد انفق العراق 85 مليون دولار على شراء مجسات القنابل في 2008 و2009.
ورغم الكشف عن انها عديمة القيمة، فانه لم يجر سحبها وما زالت احدى الوسائل الرئيسة لوقف مفجري القنابل الاعضاء في "القاعدة".
وقد اخبرني مفوض شرطة عراقي على صعيد خاص ان افراد الشرطة يعرفون ان مجساتهم لا تعمل،
ولكنهم يواصلون استخدامها لانهم مأمورون بذلك. والمفترض في بغداد هو ان احداً ما قد تلقى رشوة كبيرة لشراء "المجسات" ولا يريد الاقرار بأنها خردة.
وليس من المفاجىء ان القنابل التي تنفجر بشكل مدمر في قلب العاصمة يتبين انها قد مرت عبر نحو عشرة حواجز تفتيش من دون ان يكتشف امرها.
ويفسر الفساد اشياء كثيرة في العراق، لكنه ليس السبب الوحيد وراء مدى صعوبة قيام حكومة ذات فاعلية.
وليس من الصعب حقا العمل على غرار ما قام به صدام حسين. فأحد اجزاء المشكلة هنا هو ان الغزو الاميركي والاطاحة بصدام حسين كانت لهما عواقب ثورية،
لان ذلك نقل السلطة من البعثيين السنة الى 60 في المائة من الشعب العراقي وهم من الشيعة متحالفين مع الاكراد.
ولدى العراق طبقة حاكمة جديدة لها جذور بين السكان الشيعة في المناطق الريفية ويرأسها منفيون سابقون ليست لديهم اي خبرة في ادارة اي شيء.
وفي كثير من الاحيان، فان اسلوب حكومتهم يدور حول اعادة نظام صدام، مع فارق واحد لكون مقاليد القيادة في ايدي الشيعة. وكان يقال في السابق ان العراق يعيش تحت حكم العرب السنة من تكريت، مسقط رأس صدام حسين شمال بغداد،
اما اليوم فان سكان بغداد يشتكون من عصابة مماثلة من شيعة مدينة الناصرية تحيط برئيس الوزراء نوري المالكي.
وقد اصبح العراق من نواح كثيرة مماثلا للبنان، حيث انه ينقسم في سياساته ومجتمعه بما لا يمكن اصلاحه على الولاء للطائفة والمجتمع. وكان بالامكان التكهن بسهولة بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 7 آذار (مارس) بان معظم العراقيين سيدلون باصواتهم باعتبارهم سنة او شيعة او اكراد.
اما المناصب العليا في الحكومة وفي دوائرها فيشغلها اناس بصورة غير رسمية وفق انتماءاتهم الطائفية.
انها اسلوب فج، من حيث حصول كل فرد على حصة من الكعكة، لكن الكعكة صغيرة جدا بحيث لا ترضي اكثر من اقلية من العراقيين.
كما ان الحكومة تصاب بالضعف لكون الوزراء يمثلون بعض الاحزاب او الفصائل او الطوائف ولا يمكن اعفاؤهم من مناصبهم لكونهم منحرفين او بغير كفاءة.
وبالعودة الى بغداد الشهر الماضي، بعد ان الابتعاد عنها لفترة من الزمن، فوجئت بضآلة ما حصل من تغيير.
فالمطار لا يزال بين الاسوأ في العالم.
وعندما اردت السفر الى البصرة ، ثاني اكبر مدن العراق ومركز صناعة النفط، قالت الخطوط العراقية ان لديها رحلة واحدة في الاسبوع وانها ليست واثقة تماما متى يكون موعد المغادرة.
قد يكون مستوى العنف انخفض، لكن القلة من بين مليوني لاجئ عراقي في الاردن وسوريا يعتبرون العودة الى الوطن عملا مأمونا.
كما ان هناك 1.5 مليونا هُجروا من مساكنهم محليا، واجبروا على ترك منازلهم بسبب المذابح الطائفية في العامين 2006 و2007 ويتملكهم الذعر من فكرة العودة.
ومن بين هؤلاء نصف مليون نسمة يعيشون في مخيمات عشوائية تقول منظمة اللاجئين الدولية انها تنقصها "الخدمات الاساسية،
بما فيها المياه والمجاري الصحية والكهرباء، وقد اقيمت في اماكن موقتة – تحت الجسور وعلى جوانب الطرقات وبين مسار المخلفات".
ومن الحقائق المؤلمة بالنسبة الى هذه المخيمات انه لا بد ان ينخفض عدد الناس فيها مع تراجع القتال الطائفي، لكنها تزداد سكانا.
ويأتي لاجئون الى المخيمات هذه الايام ليس خوفا من فرق الموت، ولكن بسبب الفقر والبطالة او لان القحط لفترات طويلة قد دفع المزارعين الى التخلي عن اراضيهم.
وهناك الكثير من العراقيين الذين لم يبق لديهم شيء يبكون عليه اذا فقدوه لكنهم يشعرون بغضب شديد تجاه حكومة يرون انها تخضع لسيطرة فئة من المهووسين بالسرقة الذين يقضون على عوائد النفط العراقي.
وكما هو الحال في لبنان وافغانستان، حيث الفرق في الثروة كبير، فان الحقد الطائفي والاختلاف العقائدي يتفاعلان لتوسيع اطار الحقد داخل المجتمعات المختلفة.
ويفسر الغضب الذي يعتمل في نفوس الحرومين مدى فداحة اعمال السرقة في بغداد في العام 2003، حين هبط الناس من أحياء مدينة الصدر الفقيرة لتستولي على ممتلكات الوزارات والدوائر الحكومية.
لكن العراق يختلف عن لبنان في جانب واحد مهم. فهو دولة نفطية بلغ ريعه السنوي 60 بليون دولار العام الماضي،
ولديه ما يعتبر اكبر الاحتياطيات النفطية غير المستخرجة في العالم، ويمكن لصادرات النفط العراقي ان تتضاعف خلال العقد المقبل بموجب العقود التي تم التوقيع عليها مع شركات نفط عالمية السنة الماضية.
ومن المفروض ان يكون هناك ما يكفي من المال لرفع مستوى المعيشة ولاعادة اعمار البنية التحتية بعد اهمال طويل.
ويمكن للنفط للوهلة الاولى ان يوفر الحل لمشاكل العراق التي لا حصر لها.
الا انه ثبت في العراق في الماضي، وفي دول نفطية اخرى، انه لعنة سياسية ومباركة اقتصادية.
فالدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز تكاد تكون دولا دكتاتورية او ملكية.
وبالنسبة للحكام يبدو ان السيطرة على عوائد النفط وليس الدعم الشعبي هو مصدر سلطتهم.
وفي حال وجود معارضة فان ثروة النفط تجعل بامكان القادة تشكيل قوات امن وتمويلها لسحق تلك المعارضة.
ليس هناك من بلد في العالم يحتاج الى حل محسوب بعناية بين المجتمعات والاحزاب اكثر منه في العراق،
الا ان النفط يمكن ان يغري الحكومات على الاعتماد على القوة. وهذا ما حصل مع صدام حسين،
الذي لم تكن لديه القوة الكافية لغزو ايران والكويت من دون ثروة النفط العراقية.
والشيء ذاته يمكن ان يتكرر، وبشكل اكثر قسوة اذا حاولت حكومة فاسدة وغير مؤهلة سحق معارضيها بدلا من التصالح معها.
فالنفط لن يكون عامل استقرار في العراق.
تصاعد العنف في العراق
لندن-
نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية تقريرا عن استمرار العنف في العراق قالت فيه إن هذا التقرير "يوضح الدرجة التي ما يزال هذا العنف استثنائيا.
ومن دون أن ينتبه العالم كثيرا فإن حوالي 160 عراقيا قتلوا، وجُرح المئات، خلال الأسبوعين الماضيين.
وما تزال الخسائر المدنية في الأرواح في العراق أعلى منها في أفغانستان، رغم أن أفغانستان أصبحت تحتل في الآونة الأخيرة اهتمام وسائل الإعلام.
لكن مقتل الدراجي يجب أن يتيح وقفة لأولئك الذين يتخيلون ما بعد مرحلة دخول الاحتلال الأميركي للعراق سنواته الأخيرة،
أو أن القوات المقاتلة الأميركية يمكن حتى أن تتباطأ في انهاء وجودها في العراق إلى ما بعد الموعد المقرر لرحيلها خلال ستة أسابيع تنتهي يوم 31 آب (اغسطس).
كما أن بقية القوات ستغادر في نهاية العام 2011وفقا لاتفاقية وضع القوات التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش عام 2008 خلال أيامه الاخيرة في البيت الأبيض.
وتضيف الصحيفة: "تترك القوات الأميركية وراءها بلدا هو حطام عائم تقريبا.
بغداد تبدو مدينة تحت احتلال عسكري، مع اختناقات مرورية مرعبة ناتجة عن 1500 حاجز تفتيش وشوارع مغلقة بأميال من الجدران الاسمنتية التي تخنق المواصلات داخل المدينة.
الوضع في العراق هو من نواح عديدة "أفضل" مما كان عليه،
لكن من الصعب أن يكون شيئا آخر،
إذا أخذنا في الاعتبار أن أعمال القتل في ذروتها عامي 2006و2007 كانت بمعدل 3،000 كل شهر.
وبعد التسليم بذلك، تبقى بغداد واحدة من اخطر المدن في العالم، أكثر خطرا للسير فيها من كابول أو قندهار.
ولا يمكن تحميل اللوم كله للقيادة السياتسية الحالية. فالعراق يتعافى من 30 عاما من الدكتاتورية، والحرب والعقوبات، والتعافي يسير بتثاقل وتناقص لأن تأثير الكوارث المضاعفة التي ضربت العراق بعد العام 1980 كان هائلا.
صدام حسين صبّ الأموال في الحرب التي شنها على ايران، ولم يترك شيئا للمستشفيات والمدارس.
والهزيمة أمام التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في الكويت أدى لانهيار العملة وإلى 13 عاما من العقوبات الدولية التي وصلت حد الحصار الاقتصادي.
ولم يتعاف العراق حتى الآن من هذه الكوارث. وعندما حاولت الأمم المتحدة ترتيب استبدال لقطع الغيار في محطات الكهرباء ومنشآت المياه في التسعينات قال الصانعون الاصليون إن المعدات كانت من القدم بحيث أن قطع الغيار بحيث لم تعد تُصنع.
خلال فترة العقوبات، لم يكن لدى الحكومة أموال فتوقفت عن دفع رواتب موظفيها، الذين صاروا يتقاضون أموالا لقاء خدماتهم.
أما هذه الأيام، فهم يتلقون رواتب جيدة لكن العهد السابق الذي لم يكن فيه أي عمل يتم دون رشوة لم يذهب إلى غير رجعة. مستويات الاشباع في الفساد أدت إلى خلل وظيفي.
ومثال صغير على ذلك: إحدى الصديقات التي تدرس في جامعة ببغداد حملت وطلبت إجازة وضع لمدة شهر هي من حقها.
مسؤولو الإدارة في الجامعة قالوا إن بإمكانها الحصول على الإجازة، ولكن بشرط أن تعطيهم راتب شهر الإجازة.
وما يجعل الفساد في العراق مدمرا هو عواقبه التي تشلّ جهاز الدولة وتحول دون أدائه مهامه الأساسية.
في العامين 2004و2005 مثلا سُرقت موازنة التجنيد العسكري البالغة 1،2 بليون جنيه استرليني بكاملها،
رغم أن ذلك ربما يُفسّر بالفوضى التي سادت خلال السنوات الاولى بعد عهد صدام حسين،
حيث كان الأميركيون يقومون بالكثير من الإجراءات ولم يكن أحد يملك أي صلاحيات حقيقية.
بعد خمس سنوات، من المعقول التفكير بأن التجنيد العسكري تحسن،
خصوصا في ما يتعلق بالقطع الاساسية من تجهيزات القوى الأمنية.
وفي هذا المجال ليست هناك أفضلية أكبر بالنسبة للحكومة من وقف المفجرين الانتحاريين من تنظيم "القاعدة" الذين يقودون سيارات محملة بالمتفجرات إلى وسط بغداد ويفجرون أنفسهم خارج الوزارات الحكومية، فيقتلون ويجرحون المئات من الناس.
العراقيون يتساءلون كثيرا عن السبب في تمكن المفجّرين من المرور دون ان يشتبه بهم أحد خلال حواجز عديدة.
خلال العام الماضين أصبح واضحا أن هناك سببا بسيطا إلى حد مذهل لذلك، يفسر الضعف الكبير لآلة الدولة العراقية.
الحقيقة غير الاعتيادية هي أن إبقاء المفجّرين خارج بغداد ، على الأقل،
يتعرقل لأن جهاز كشف القنابل الأهم الذي يستخدمه الجيش والشرطة للعثور على المتفجراتتبين أنه مزيف.
الحكومة دفعت اموالا طائلة للحصول على كاشف المتفجرات، الذي يسميه العراقيون "الصوتي"،
على الرغم أنه ياتي دون مصدر للطاقة- ومن المفترض أن يحصل على الطاقة من مشغّله،
الذي يفترض أن يحرك قدميه ليولد الطاقة الساكنة.
ورغم أن "الصوتي" بلا جدوى، فإن سوارا بلاستيكيا أسود مربوطا بعصا فضية تشبه هوائي التلفزيون في مقدمته،
يمثل الطريقة الأساسية التي يتم بها فحص المركبات المشبوهة في بغداد من جانب الجيش والشرطة.
وإذا كان فيها أسلحة أو متفجرات فإن السوار يشير إليها وهو يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها جهاز كشف المعادن.
المذهل في كاشف القنابل، المعروف رسميا بجهاز "أيه دي إي-651"،
هو أن الخبراء الحكوميين والصحف ومحطات التلفزة كشفوا مرارا عن عدم جدواه.
وكانت بريطانيا تنتجه اصلا، في مزرعة ابقار مهملة في مقاطعة سومرست، لكن المدير الإداري للشركة الصانعة اعتقل في المملكة المتحدة بتعمة التزييف وتقرر حظر تصدير الجهاز.
والمكون الإلكتروني الوحيد في الجهاز هو قرص صغير لا يزيد ثمنه عن بنسات قليلة، شبيه بالذي يلصق بالملابس في المحلات الراقية للحيلولة دون نشل الملابس والخروج بها دون دفع ثمنها.
وبالرغم من ان صنع كل "مجس" لا يكلف سوى نحو 50 دولاراً، فقد انفق العراق 85 مليون دولار على شراء مجسات القنابل في 2008 و2009.
ورغم الكشف عن انها عديمة القيمة، فانه لم يجر سحبها وما زالت احدى الوسائل الرئيسة لوقف مفجري القنابل الاعضاء في "القاعدة".
وقد اخبرني مفوض شرطة عراقي على صعيد خاص ان افراد الشرطة يعرفون ان مجساتهم لا تعمل،
ولكنهم يواصلون استخدامها لانهم مأمورون بذلك. والمفترض في بغداد هو ان احداً ما قد تلقى رشوة كبيرة لشراء "المجسات" ولا يريد الاقرار بأنها خردة.
وليس من المفاجىء ان القنابل التي تنفجر بشكل مدمر في قلب العاصمة يتبين انها قد مرت عبر نحو عشرة حواجز تفتيش من دون ان يكتشف امرها.
ويفسر الفساد اشياء كثيرة في العراق، لكنه ليس السبب الوحيد وراء مدى صعوبة قيام حكومة ذات فاعلية.
وليس من الصعب حقا العمل على غرار ما قام به صدام حسين. فأحد اجزاء المشكلة هنا هو ان الغزو الاميركي والاطاحة بصدام حسين كانت لهما عواقب ثورية،
لان ذلك نقل السلطة من البعثيين السنة الى 60 في المائة من الشعب العراقي وهم من الشيعة متحالفين مع الاكراد.
ولدى العراق طبقة حاكمة جديدة لها جذور بين السكان الشيعة في المناطق الريفية ويرأسها منفيون سابقون ليست لديهم اي خبرة في ادارة اي شيء.
وفي كثير من الاحيان، فان اسلوب حكومتهم يدور حول اعادة نظام صدام، مع فارق واحد لكون مقاليد القيادة في ايدي الشيعة. وكان يقال في السابق ان العراق يعيش تحت حكم العرب السنة من تكريت، مسقط رأس صدام حسين شمال بغداد،
اما اليوم فان سكان بغداد يشتكون من عصابة مماثلة من شيعة مدينة الناصرية تحيط برئيس الوزراء نوري المالكي.
وقد اصبح العراق من نواح كثيرة مماثلا للبنان، حيث انه ينقسم في سياساته ومجتمعه بما لا يمكن اصلاحه على الولاء للطائفة والمجتمع. وكان بالامكان التكهن بسهولة بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 7 آذار (مارس) بان معظم العراقيين سيدلون باصواتهم باعتبارهم سنة او شيعة او اكراد.
اما المناصب العليا في الحكومة وفي دوائرها فيشغلها اناس بصورة غير رسمية وفق انتماءاتهم الطائفية.
انها اسلوب فج، من حيث حصول كل فرد على حصة من الكعكة، لكن الكعكة صغيرة جدا بحيث لا ترضي اكثر من اقلية من العراقيين.
كما ان الحكومة تصاب بالضعف لكون الوزراء يمثلون بعض الاحزاب او الفصائل او الطوائف ولا يمكن اعفاؤهم من مناصبهم لكونهم منحرفين او بغير كفاءة.
وبالعودة الى بغداد الشهر الماضي، بعد ان الابتعاد عنها لفترة من الزمن، فوجئت بضآلة ما حصل من تغيير.
فالمطار لا يزال بين الاسوأ في العالم.
وعندما اردت السفر الى البصرة ، ثاني اكبر مدن العراق ومركز صناعة النفط، قالت الخطوط العراقية ان لديها رحلة واحدة في الاسبوع وانها ليست واثقة تماما متى يكون موعد المغادرة.
قد يكون مستوى العنف انخفض، لكن القلة من بين مليوني لاجئ عراقي في الاردن وسوريا يعتبرون العودة الى الوطن عملا مأمونا.
كما ان هناك 1.5 مليونا هُجروا من مساكنهم محليا، واجبروا على ترك منازلهم بسبب المذابح الطائفية في العامين 2006 و2007 ويتملكهم الذعر من فكرة العودة.
ومن بين هؤلاء نصف مليون نسمة يعيشون في مخيمات عشوائية تقول منظمة اللاجئين الدولية انها تنقصها "الخدمات الاساسية،
بما فيها المياه والمجاري الصحية والكهرباء، وقد اقيمت في اماكن موقتة – تحت الجسور وعلى جوانب الطرقات وبين مسار المخلفات".
ومن الحقائق المؤلمة بالنسبة الى هذه المخيمات انه لا بد ان ينخفض عدد الناس فيها مع تراجع القتال الطائفي، لكنها تزداد سكانا.
ويأتي لاجئون الى المخيمات هذه الايام ليس خوفا من فرق الموت، ولكن بسبب الفقر والبطالة او لان القحط لفترات طويلة قد دفع المزارعين الى التخلي عن اراضيهم.
وهناك الكثير من العراقيين الذين لم يبق لديهم شيء يبكون عليه اذا فقدوه لكنهم يشعرون بغضب شديد تجاه حكومة يرون انها تخضع لسيطرة فئة من المهووسين بالسرقة الذين يقضون على عوائد النفط العراقي.
وكما هو الحال في لبنان وافغانستان، حيث الفرق في الثروة كبير، فان الحقد الطائفي والاختلاف العقائدي يتفاعلان لتوسيع اطار الحقد داخل المجتمعات المختلفة.
ويفسر الغضب الذي يعتمل في نفوس الحرومين مدى فداحة اعمال السرقة في بغداد في العام 2003، حين هبط الناس من أحياء مدينة الصدر الفقيرة لتستولي على ممتلكات الوزارات والدوائر الحكومية.
لكن العراق يختلف عن لبنان في جانب واحد مهم. فهو دولة نفطية بلغ ريعه السنوي 60 بليون دولار العام الماضي،
ولديه ما يعتبر اكبر الاحتياطيات النفطية غير المستخرجة في العالم، ويمكن لصادرات النفط العراقي ان تتضاعف خلال العقد المقبل بموجب العقود التي تم التوقيع عليها مع شركات نفط عالمية السنة الماضية.
ومن المفروض ان يكون هناك ما يكفي من المال لرفع مستوى المعيشة ولاعادة اعمار البنية التحتية بعد اهمال طويل.
ويمكن للنفط للوهلة الاولى ان يوفر الحل لمشاكل العراق التي لا حصر لها.
الا انه ثبت في العراق في الماضي، وفي دول نفطية اخرى، انه لعنة سياسية ومباركة اقتصادية.
فالدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز تكاد تكون دولا دكتاتورية او ملكية.
وبالنسبة للحكام يبدو ان السيطرة على عوائد النفط وليس الدعم الشعبي هو مصدر سلطتهم.
وفي حال وجود معارضة فان ثروة النفط تجعل بامكان القادة تشكيل قوات امن وتمويلها لسحق تلك المعارضة.
ليس هناك من بلد في العالم يحتاج الى حل محسوب بعناية بين المجتمعات والاحزاب اكثر منه في العراق،
الا ان النفط يمكن ان يغري الحكومات على الاعتماد على القوة. وهذا ما حصل مع صدام حسين،
الذي لم تكن لديه القوة الكافية لغزو ايران والكويت من دون ثروة النفط العراقية.
والشيء ذاته يمكن ان يتكرر، وبشكل اكثر قسوة اذا حاولت حكومة فاسدة وغير مؤهلة سحق معارضيها بدلا من التصالح معها.
فالنفط لن يكون عامل استقرار في العراق.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة rss_net في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-15-2023, 05:10 PM
-
بواسطة rss_net في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-06-2022, 11:50 AM
-
بواسطة حيدر المرعب في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 01-15-2014, 09:42 AM
-
بواسطة فاضل في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-03-2013, 07:13 AM
-
بواسطة فطرية في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 07-02-2010, 04:16 AM
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى

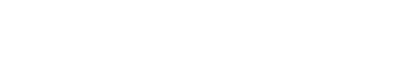







 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات