-
 ليس كل ما يلمع ذهبا....تداعيات العولمه...وتمييزها العنصري
ليس كل ما يلمع ذهبا....تداعيات العولمه...وتمييزها العنصري

لأن ما يلمع ليس كله ذهبا، فإن ما يلمع في الحضارة الحديثة أو حضارة الحضارات، أو منتهى التحضر على حد زعم المؤرخ والمفكر الأمريكي فوكوياما، ليس كله حضاريا وليس كله ذهبيا وليس كله نهاية للتاريخ؛ ويبدو أن قاطرة هذه الحضارة المغرورة قد تجاوزت أقصى نقطة في اندفاعتها وصعودها، لأن الاتجاه الهبوطي لا يبدأ إلا بعد تجاوز أقصى ارتفاع في القمة، وهكذا هو انحدار الحضارات الذي يشبه أي انحدار آخر، وإرهاصاتها تكون بالتورط في ارتكاب نفس أخطاء الحضارات القديمة، ولكن بأزياء وأمزجة وطقوس وجرائم مختلفة.
لقد كان استعباد أجناس من البشر بانتزاع آدميتهم وحريتهم وحقوقهم، وبتحويلهم إلى رقيق يباع ويشترى في أسواق النخاسة كأي سلعة أو بضاعة، أو بتسخيرهم للخدمة والأعمال الشاقة المضنية، خطيئة أو شرّا أو ممارسة أو مشكلة لم تنج منها حضارة من الحضارات، وإن تفاوتت في معالجاتها الإنسانية والأخلاقية، وطبيعة العلاقة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تجاه هذه الطبقة المهمشة أو المسلوبة الآدمية؛ وكما تُعَد حضارة القيم الديموقراطية والليبرالية واحدة من أسوأ الحضارات التي احترفت التمييز العنصري منذ نعومة أظفارها، فإن هذه الخطيئة تُعَد واحدة من أسوأ خطيئات تلك الحضارة التي يقودها الغرب، إذ لم تتوان هذه الحضارة المادية إلى نخاعها لحظة من تاريخها عن استغلال هذه الفئة من البشر وامتهان كرامتها وإذلالها بلا إنسانية وبلا تحضر، بل واعتبرتها فكريا نوعا من البهائم التي لا تجيد إلا الأعمال الشاقة حتى الموت، وتركتها بقوة القانون والعُرف الاجتماعي على هامش الحياة الاجتماعية تعاني وتجوع وتموت، قربانا للمجتمع الإسبرطي الذي كان يترفّه ويتخم ويموت من البذخ والترف والتنعم، مما يمتصه من كدح أولئك الممتهنين ومن عرقهم ومن إنسانيتهم.
ولأن الحضارة الحديثة لها طابع الأناقة، فإنه بدلا من استخدام مفردات أو مصطلحات قاسية ومتخلفة ودارجة مثل الاسترقاق أو الاستعباد، فقد ظهر مصطلح التمييز العنصري، كمصطلح مبتكر وناعم لا يجرح مشاعر الإنسان الأبيض، وإن كان هذا المصطلح من الناحية العملية والفكرية قد طوى تحت جناحه ألوانا لم تشهد لها البشرية مثيلا من الاسترقاق أو الاستعباد؛ فبدلا من استعباد البشر بالقوة وبمصادرة حرية حركتهم أو حرية اتخاذهم أي قرار مهما كان شخصيا، حين كانت سفن النخاسين تسرق الأفارقة السود من بين آبائهم وأبنائهم، وتنقلهم عبر المحيطات إلى أمريكا وأوروبا في ظروف معيشية مزرية لا تليق بالبهائم والدواب؛ فقد تحوّر هذا الاستعباد المباشر والجسدي إلى نوع مختلف من الرقيق، فظهرت عبودية العقول والأفكار والمهارات، وبدلا من السفن التي تسرق العبيد قامت عقود العمل وعروضها المالية وأحيانا فوهات البنادق بوظيفة نقل الأذكياء والعباقرة من مساقط رؤوسهم في بقاع الأرض الفقيرة بفرص العمل الفائق المهنية، إلى المختبرات ومراكز البحث العلمي والجامعات والمؤسسات الصناعية العملاقة في البلدان المتقدمة، أو أحيانا اجتذاب المتميزين دراسيا ممن يتلقّون تعليمهم في تلك البلدان، أو من يتخلّون منهم عن أديانهم ويعتنقون مفردات الحياة الغربية كدين جديد، ممن يقعون تحت تأثير إغراءات الوظائف ذات الأجور الفاحشة، أو فرص الإثراء، أو إتاحة مجالات تفجير الطاقات العلمية والإبداعية، أو الحصول على الجنسية والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، أو التمتع بحق الإقامة الدائمة في فردوس الحضارة؛ وعندما بدأت دول "الحرية والديموقراطية والتمدن" تتمدد جغرافيا وسياسيا بفضل فائض القوة والقدرة، أصبح أبناء الشعوب الخاضعة للوصاية أو الانتداب أو الاغتصاب (الاستعمار المباشر) أو التدويل، أو حتى الداخلة في اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للحماية العسكرية أو للتبادل التجاري أو الثقافي، عبيدا أو رقيقا بالتبعية لصالح الطرف القوي في تلك الاتفاقيات غير المتكافئة، وتحولوا إلى مواطنين تحت الاختبار من الدرجة العاشرة لصالح تلك الأطراف المغتصبة، وبدلا من تسميتهم عبيدا أصبحوا متمتعين بالأفضلية، ولكن مع تمييزهم عنصريا، لأنهم لن يجدوا سبيلا إلى حق المواطنة الكامل إلا لعدة أجيال قادمة من أجيالهم، وبقدر ما يتقبل السيد المتحضّر التنازل طواعية عن جزء من ذاكرته ونزعته الاستعبادية.
هكذا أصبحت هذه الحضارة الأنيقة على شفير مأزق التشبع من أصناف هذه العمالة المسترقّة وأجيالها التي تناسلت مع الزمن، حتى باتت تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة، مع ارتفاع تكلفة التخلص منها بإعادتها إلى موطنها الأصلي بعد انقضاء بضع عقود من الزمن، فكان ضرورة اجتماعية وسياسية- وأيضا أناقة حضارية- أن تتفتّق أفكار النخاسين الجدد عن حلول مبتكرة لإدماج هذه الفئة المميزة عنصريا في المجتمع، لا حبّا في إدماجها ولكن هروبا من المأزق الاجتماعي الذي ينذر بالثورة وبتزايد معدلات الجريمة وبالهجرة المعاكسة، ويهدد بتعريض المكتسبات الحضارية للتدمير على يد الملونين الغاضبين والمتمردين على أوضاعهم اللاإنسانية وحقوقهم السياسية والاجتماعية المهدورة، وأيضا لاستغلال هذا الرقيق الجديد- بحكم مستويات تعليمهم المتدنية- في المهن والحرف والوظائف التي يتنزه الأسياد البيض عادة عن الانخراط فيها، كالوظائف العسكرية والدفاع المدني والمهن الحقيرة وذات المخاطر العالية؛ لقد كانت دوافع الفزع من مستقبل الوحدة السياسية والرفاهية الاجتماعية أقوى من دوافع التصحيح أو الاعتراف بالذنب، وهكذا وجد الرجل الأبيض "النبيل" نفسه مضطرا إلى أن يتعايش مع الرجل الملون "الوضيع"، وأن يحترمه وأن يختلط به، ولكنه لم يستطع أن يتقبله كإنسان، بل تقبله كشيء أو كمُكوّن اجتماعي، فكان طبيعيا لمن يعتقد جازما بأن الإنسان كان قردا في الأصل، أن يصل إلى هذا المأزق الفكري، ولهذا كان كثيرا ما يحاول وبشتى وسائل البحث العلمي أن يتوصل إلى اكتشاف فوارق عضوية أو عقلية أو نفسية جوهرية تبيح له انتزاع إنسانية الملون وآدميته، أو تكتشف أن أصله انحدر من حمار وليس من قرد، ولكن نتائج الوسائل العلمية الموضوعية بطبيعتها كانت دائما وأبدا تكرس أخوّة البشر وتقول: "كلُّكم لآدم، وآدم من تُراب"؛ على أعتاب القرن الحالي، وصل الحال بمجتمع كالمجتمع الأمريكي إلى أن أصبحت شريحة مواطنيه الملونين (الرقيق سابقا) شوكة في الحلق، ابتلاعها مؤلم وإخراجها مؤلم، وكان وصول رجل أسود أو بلون الشيكولاته إلى عرش الرئاسة الأمريكية، لا نجاحا لنضال مارتن لوثر كنج ولا تكليلا لأخلاقيات أبراهام لنكولن ومبادئه، بل نجاحا لضغوط المأزق الاجتماعي والسياسي الذي وجدت أمريكا نفسها بجلالة قدرها ضئيلة الحجم في مواجهته، ومسلوبة القدرة.
في أجواء هذا الذوبان القسري والمقيت أو غير المرحب به للفوارق الإثنية والعرقية والحضارية والتاريخية، بين البيض والملونين أو بين السادة والعبيد أو بين الآلهة والأرواح الشريرة، قدمت العولمة نفسها إلى العالم على أنها خيار تاريخي وحلٌّ حضاري يحمل قيم الإنسانية والمساواة والوحدة البشرية، فكان طبيعيا أن تنتقل تركة التمييز العنصري إلى هذا الإله الجديد ليصبغها بصبغة وصاياه وتعاليمه الجديدة؛ ولكن العولمة لم تكن في الحقيقة رغبة أممية لجمع دول العالم واقتصاداته وثقافاته تحت سقف واحد من المصالح العادلة، ولا خندقا واحدا لمواجهة نفس التحديات، ولم تكن توجها فكريا أو حركة سياسية عالمية مستقلة، بل كانت إملاء امبرياليا رسمته الدول العظمى، وعقد إذعان دخلت دول العالم تحت سقفه لا برغبتها ولا بإرادتها، إنها بوضوح أكثر، برنامج إجباري "لأمركة" العالم وليس عولمته، ومن هنا تأثرت العولمة بالتاريخ الأمريكي الذي حفر أخاديد عميقة من وحشية العنصرية ودمويتها في النفسية الأمريكية، فترعرعت على اقتراف كل فواحش التمييز العنصري؛ ومن هنا جاءت مخاوف العولمة من افتضاح ظاهرها المنمق وإنجازها الحضاري عن باطن قميء وعن أجندة خفية وغير إنسانية دافعا لمحاولة تجميل ذلك الباطن بأي وسائل مبتكرة ولا سيما في الشأن العنصري، لقد حاولت العولمة أن تخفي عنصريتها وانحيازها وراء جدار سميك من قيم التوافق والتشارك والتساوي والحياد بين أمم العالم وشعوبه وانتماءاته، ولكن مساحيق الأفكار التطبيقية فشلت في إخفاء تجاعيد ذلك الباطن وحقيقته البشعة، كما لم تتمكن العولمة من تجنب الوقوع تحت تأثير نفس العوامل والمؤثرات والنواميس الطبيعية التي تحكم نزعة التنوع والاختلاف والتفاوت، باعتبارها فاكهة هذه الحياة، ولازمة من لوازمها؛ ولكن العولمة الشريرة في مواجهتها للمأزق العنيد عادت لتنزلق من جديد في مستنقع التمييز العنصري، ولكن بأساليب وممارسات مختلفة، بل إن المشكلة استفحلت على نحو غير محسوب وغير قابل للسيطرة، وانتقلت أعراض التمييز العنصري من شكله البدائي البسيط إلى نوع متطور ومعقد من التمييز الذي لا يصنف البشر فقط عنصريا، بل ومعهم المجتمعات والثقافات والجغرافيا، ويصنع من تفاوت طبائعهم وقابلياتهم الاستعمارية وهشاشة ثوابتهم الثقافية طبقيات ومستويات مختلفة، قبل أن تُصدر العولمة فيهم حكمها النهائي، رميا بالتمييز العنصري.
على المستوى الدولي، دخلت الدول القوية في اتفاقيات التجارة العالمية باعتبارها الغطاء الشرعي للعولمة، وكان ذلك إيذانا بإعلان العولمة الكفر بمبادئها المعلنة منذ اليوم الأول، والبدء في ممارسة طقوس التمييز العنصري، لأن دخول تلك الدول كان اختياريا وليس إلزاميا، ووفق إملاءاتها التي أجبرت تلك الاتفاقيات على تعديل أحكامها، ثم إنها دخلت كجبهة واحدة، لتعمل على اقتسام الفرائس الاقتصادية والاستراتيجية من الدول الضعيفة عسكريا والغنية اقتصاديا فيما بينها؛ بينما دخلت الدول الضعيفة في تلك الاتفاقيات إكراها وفرادى، باعتبارها دولا مسيطرا عليها أو مغتصبة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا، أي نصف راشدة، ولتكريس الهيمنة عليها هيمنة ثلاثية الأبعاد، الدول العظمى الاستعمارية ثم هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ثم منظمة التجارة العالمية؛ ورغم ذلك كانت بعض الدول الضعيفة تُعامَل معاملة عنصرية مختلفة، لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو حتى جغرافية، فالدول الواقعة منها تحت جناح القارة العجوز، والدول التي تملك شيئا من التقنية المتطورة، والدول "المؤدبة الحكيمة" التي تنازلت عن لغتها وثقافتها وهويتها لصالح الثقافة الفرانكوفونية أو الأنغلوسكسونية، كانت دولا تحظى بأفضلية تمييزية قوية في مواجهة الدول والمجتمعات المتخلفة علميا وتقنيا، أو التي حاولت التمسك بثقافتها وهويتها وموروثها التاريخي، فكان ذلك كله تمييزا عنصريا في تطبيق شروط الانضمام أو الولوج إلى معبد العولمة الأعظم.
في مجال عولمة قوة العمل، أخفقت العولمة من جديد في إيقاف نزيف التمييز العنصري، واستمرت في إضافة المزيد من طوابير العبيد والرقيق إلى المجتمعات الإسبرطية المتقدمة، وبأنواع مختلفة من العمالة، بدءا من المهن العالية المهارة، إلى تجارة النساء أو الرقيق الأبيض ومن خلال مهن "محترمة" كعرض الأزياء والرياضة والإعلام والفن، إلى المتاجرة بالأطفال وبالأعضاء البشرية وحتى بالتحف والآثار التي تمنح العولمة الدول القوية حق سرقتها وامتلاكها، بينما تُسقط هذا الحق عن الأصحاب الشرعيين لتلك الآثار، وكل ذلك بفضل قيم التمييز العنصري الجديد ومبادئه؛ وبهذا ظل حق الباحثين عن فرص العمل في المجتمعات المتقدمة من أبناء المجتمعات المتخلفة، وتحت غطاء حق انتقال العمالة الذي تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حقا مشروطا، فإما أن يرزح العامل تحت أغلال التمييز العنصري باعتباره عاملا مهاجرا لا يحصل من ناتج عمله من الأجر أو التعويضات أو الضمانات الوظيفية إلا على نصف أو ربع ما يحصل عليه المواطن الأصلي، ولو كانت إنتاجيته تفوق ذلك المواطن، بينما تتدخل العولمة لحماية المواطن الأمريكي والأوروبي الذي يعمل في أي دولة متخلفة، ولو كان غير مؤهل للوظيفة أو لا تنطبق عليه شروط شغلها، وتكشر عن أنيابها حتى تضمن لهذا الجنس النبيل حصوله على كامل ما لا يستحق من الأجور والتعويضات؛ فكان ذلك تمييزا عنصريا في تنظيم حركة قوة العمل.
على المستوى المهني، بدأت فوارق اللون واللغة والعرق والثقافة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتماء السياسي تنحسر بين شعوب القرية العالمية التي حاولت العولمة تأسيسها، ولكنه كان انحسارا طارئا ومحصورا بين الأفراد المنتمين إلى قاسم ثقافي أو مهني أو اجتماعي مشترك، كأن يكونوا أصحاب مهنة واحدة، أو يكونوا بمستوى متقارب من الثراء، أو أن تجمعهم جنسية واحدة، أو أن يعتنقوا دينا أو مذهبا واحدا؛ فمن حيث المهنة الواحدة نجد فوارق التمييز العنصري من حيث اللون أو الجنس أو الثقافة تسقط بين محترفي الرياضة بعضهم البعض، أو الفنانين أو غيرهم من المهن، فالسود والبيض والجرمان والأتراك والوثنيون والبوذيون تجمعهم ساحات هذه المهنة وصالاتها وأنديتها وعلاقاتها الخاصة، ويتناسون كل فوارق اللون أو الدين أو الأصل التي كانت تميزهم ذات يوم، أما خارج حدود المهنة فإن لاعب الكرة الإنغليزي ما يزال ينظر إلى عامل نقل القمامة الهندي الذي يعمل في شوارع لندن بفوقية وتعال وعنصرية، ومذيعة نشرة الأخبار الفرنسية ما تزال تنظر بنفس التعالي والفوقية لموظفة الاستقبال الأثيوبية في أحد فنادق الشانزليزيه؛ وهكذا بالنسبة لفئة الأثرياء ورجال الأعمال، وهكذا بالنسبة للأوروبيين والأستراليين، وهكذا بالنسبة للنصارى والمسلمين حتى أن المسلم العربي يشعر بالفارق العنصري الذي يجعل أي عربي مهما كان لونه أو انتماؤه السياسي أو دينه أو مستواه الاقتصادي أفضل من أي أفغاني ولو كان مسلما، لا انتصارا للقومية العربية ولكن ازدراء بالآخر، وإرضاء لنعرة التمييز العنصري؛ ولعل المتابع للمشهد السياسي يلاحظ بوضوح كيف أن حركات الإثنيات والأصول العرقية ولو كانت على مستوى أقليات آيلة للانقراض، بدأت في عهد العولمة تنتعش وتطل برأسها وتطالب بحقوقها السياسية والثقافية والاجتماعية باعتبارها أقليات، لا باعتبارها قطعة فسيفسائية من نفس اللُّحمة الاجتماعية والثقافية والسياسية للدولة أو الإطار السياسي الذي يجمعها مع بقية إجزاء المجتمع.
ولأن العقود القليلة القادمة ستبقى عقودا عولمية، وستتمتع بحماية الدول العظمى لتمرير ما تبقى على أجندتها الخفية، وسيستمر هذا الخواء الفكري وهذا الإفلاس الحضاري لليبرالية أمام مأزق التمييز العنصري، فإن تكلفة مساحيق التجميل اللازمة لإخفاء مظاهر ذلك التمييز ستبقى باهظة ومرهقة، لأن هذا التمييز المتفجر والمتفاقم لم يجد حلولا إنسانية متوائمة مع الفطرة البشرية المختلفة تماما عن حيوانات المختبر، ولأن المال والطعام والاشتهاءات الحياتية أثمان غير مناسبة وغير كافية وحدها لشراء الركام النفسي والعاطفي والأخلاقي، أو لإجراء العملية الجراحية لاقتلاعه من أعماق النفسية البشرية، مقابل التنازل عن عصبية اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء الطائفي أو الموروث الثقافي والتاريخي؛ ولأن العولمة بطبيعتها آلة متحركة تعمل بالوقود المعدني، وتُدار عن بُعد بواسطة أسوأ وأشنع تجربة حضارية شهدها التاريخ للتمييز العنصري، فهي أحرى بأن لا تمتلك شيئا من القيم والمبادئ والمفاهيم الإنسانية لتشتري ولو شيئا قليلا من ذلك الركام الثقيل، وهكذا تكون البشرية مرشحة للبقاء طوال العهود المتبقية من عمر العولمة معذبة بصداع التمييز العنصري، وتمضي حاملة على أكتافها كل آلامه وتداعياته
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة rss_net في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 06-03-2020, 02:03 PM
-
بواسطة الارشيف في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 04-03-2015, 04:36 PM
-
بواسطة سالي في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 05-25-2014, 02:54 PM
-
بواسطة حيدر المرعب في المنتدى منتدى أخر خبر ودلالاته
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 01-25-2014, 03:23 AM
-
بواسطة هاشم الطرفي في المنتدى منتدى أستراحة الأعضاء
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-16-2013, 04:41 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
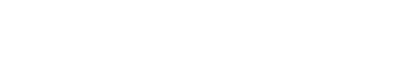









 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات