-
 معاناة اللغة العربية بين أهلها
معاناة اللغة العربية بين أهلها
لا نجد في عالمنا العربي من المتخصصين بشأن اللغة والمثقفين المهتمين بأمورها، من لا يقر ويعترف بمظاهر ضعفنا اللغوي، ضعفا بدأنا نتوارثه عبر الأجيال، حتى صار يتفاقم ويستفحل ويتراكم عقدا بعد عقد، وسنة بعد أخرى، صار أبناؤنا ينهون ست سنوات في المدارس الابتدائية وينتقلون إلى المرحلة الثانوية وهم لا يستطيعون قراءة سطر واحد على بعضه، وأصبحوا ينهون المرحلة الإعدادية والثانوية وينتقلون إلى الجامعة وهم لا يستطيعون كتابة اسطر معدودة يعبرون بها عن أفكارهم وأخيلتهم وتجاربهم الشعورية، ويتخرجون في أقسام اللغة العربية وأقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات ولا يجيدون قراءة القرآن الكريم، أصبح الأساتذة المتخصصون لا يبالون بالأخطاء ولا يتحرزون عن ارتكابها حتى وهم يتلون ما يكتبون، صار اكبر الصحفيين وأبرز الكتاب يحتاج إلى من يراجع له ما يكتب ويصحح له أخطاءه اللغوية والنحوية والأسلوبية والإملائية، وتجد أقسام التصحيح والتصويب اللغوي اكبر الأقسام في الصحيفة للحاجة الماسة إليه، ومع ذلك صار الخطأ شائعا في الصحافة والكتب وفي نشرات الأخبار والمراسلات الرسمية وفي اللافتات والعوارض، وحتى أسماء المؤسسات والشوارع، أصبح الأئمة والخطباء في المساجد يكبون ويسقطون بتواتر في الجار والمجرور.
لقد استفحل الأمر وبات الضعف والتردي يهدد كيان الأمة ومستقبلها، وينذر بخطر مسخ هويتها، واجتثاث أهم مقومات وجودها وهو اللغة، أضحى المتحدث لا يستطيع أن يفضي بعبارة واحدة من دون أن يطعمها بمصطلحات وألفاظ أجنبية متباهيا من دون إحساس بالذنب، حتى التحية بالسلام الذي تميز به العرب المسلمون أخذنا نتداوله باللغات الأجنبية، أمسينا لا نستطيع مراجعة المؤسسات كالمستشفيات ومحلات الصرافة والشركات والمصالح ومؤسسات الخدمات العامة إذا لم نكن نجيد اللغة الأجنبية، فحال الواقع الذي نحن عليه اليوم ما عاد يشير إننا امة عريقة لها تراث مشهود وماض مشرق، يضعنا أمام مسئولياتنا القومية والعقائدية، فضعف اللغة العربية وضعف حصادها وأدائها الذي يطالعنا بعوارضه اليوم ليس وليد قصور في ذات اللغة، وإنما بسبب فقر نصيب كل منا باللغة بفعل سياسات تعليمية وخطط خاطئة خضعت لهيمنة شخصيات انثقفت بتمدن الغرب، لضعف ولائها القومي وانغمست بتنفيذ خططه وأتمرت بأمره، طوعا وكرها خططا دبر لها ماكرون، ووقفت خلفها دوافع استعمارية ودول كبرى تكن للأمة العربية والوطن العربي عداء تاريخيا عززته التجارب، وغفل عنه الحكام وتهاون أبناء الأمة ومثقفيها في مقاومة غزو استهدف مقومات الأمة لإضعاف كيانها ومسخ هويتها، والقضاء على مقومات نهضتها.
فمنذ زوال الخلافة العباسية عام 656هــ واجه العالم الإسلامي هجمة شرسة كبرى وشاملة لم تقتصر على جانب دون آخر، ولا منطقة دون أخرى، حيث قتل المغول بقيادة هولاكو ليلتها القادة والعلماء ومليون من أهالي بغداد وجندها، واحرقوا بيت الحكمة الذي يضم نفائس الكتب، وقذفوا بكتب المكتبات في نهر دجلة فأصبح ماؤه يجري بخطوط امتزج فيها لون الدم بلون الحبر، وبعد قرن ونصف عاد تيمورلنك ليعمل هرما من جماجم البغداديين، وحكمت العراق بعده أقوام وممالك وافدة من العجم، الفرس و الترك ودول الخروف الأبيض والخروف الأسود، والعثمانيون والصفويون وتعاقبت على الوطن العربي حملات الصليبين، وتولى غير العرب مقاليد الأمور من المماليك بحكم كونهم مسلمين، ومن الطبيعي أن تتدهور الحالة في ظل غياب قيادة عربية تتجاوب مع تطلعات الأمة والوطن طيلة ستة قرون، “والأرض لا تلعب إلا مع أصحابها”
وظلت الحضارة العربية واللغة زمنا بعد سقوط الخلافة العباسية تتمتع بشبابها وحيويتها وتقاوم قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيا مع طول الأمد، ولكنها بقيت موضع احترام واستقطاب طيلة القرون الوسطى، فالغربيون المتنورون كان يهمهم البحث في التراث العربي ومراجعته والاستفادة من معارفه، وعوامل تقدم العرب الحضارية، واستمر هذا الشغف حتى العصر الحديث حيث بدأ الاستعمار الغربي العسكري للمنطقة العربية، الذي كان ظالما ولا أخلاقيا، يتعمد الإساءة إلى الحضارة العربية ولغتها، وبتوالي المحن كان لابد أن يضعف حصاد العربية الفكري، وإن لم تفقد اللغة ألقها الإبداعي مباشرة.
وفي النظام الدولي الجديد والنهضة الحديثة بدأت أمريكا الصاعدة على وجه الدنيا، وأوربا الشمطاء المتصابية تتعاونان فيما بينها لتنال من صمودنا وتكامل قيمنا، فقد وضع المستعمرون في حساباتهم أن أمن الغرب يكمن في ذل العرب المسلمين، وأول وسيلة لزعزعة الكيان العربي ومسخ هويته يبدأ بإضعاف اللغة العربية لارتباطها مباشرة بالقرآن الكريم مصدر قوة الأمة وأساس عقيدتها، فإذا ضمنوا ذلك تيسرت لهم الهيمنة على مفاتيح حياتهم، وفي ضوء هذه الأهداف برمجوا خططهم الخبيثة للنيل من هوية الأمة وعناصر وجودها بغزو ثقافي ماكر تحت ستار العلم والتمدن والمعاصرة، وبصيحات كان آخرها دعوتهم على العولمة، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
بعد الحرب العالمية الأولى تآمرت بريطانيا وفرنسا على العرب، وقررتا نكث الوعود والعهود وعدم إعطاء العرب حق الاستقلال في دولة موحدة كما وعدوا الشريف حسين، وأدرك الغرب وكانت تتصدر الدفاع عن مصالحه آنذاك بريطانيا العظمى، أن لن تتمكن دولة أوربية واحدة بمفردها السيطرة على العرب من المحيط إلى الخليج، وأن وضع العرب تحت سيطرة دولة أوربية واحدة لن يحقق أحلام الغربيين وأهدافهم بتفتيت الوطن العربي، وإنما يُبقي كيان العرب موحدا ومقاومتهم واحدة، ولذلك فكروا بخبث ومكر واتفقوا في سايكس بيكو على تقسيم الوطن الكبير إلى أجزاء يتقاسمون السيطرة عليها، كل جزء يتبع دولة أوروبية تفرض لغتها وثقافتها، ونمط الحياة الغربي بالأسلوب الذي تراه كفيلا بمسخ الهوية العربية الإسلامية في الجزء الواقع تحت انتدابها، وعليها العمل على تغيير نمط الحياة، وتعمدوا غرس بذور التفرقة بين القيادات لأتفه الأسباب، وإشاعة ثقافة تبادل التخوين وتراشق التهم لتكريس الانشقاق وسياسة المناكفة وضمان دوام الصراع بين هذه الأجزاء وابتعادها عن بعضها، فيسهل فرنجة المجتمع العربي، وإيجاد مجتمعات مختلفة الرؤى متطبعة بأكثر من ثقافة ولغة، وهكذا يستطيعون تمزيق كيان الأمة الموحد وتفرقتها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا.
استوت اللعبة لانكلترا وفرنسا، واجتهدوا في امتصاص دماء الشعوب ونهب خيراتها، ولكنهم واجهوا مقاومة شرسة فأيقنوا بصعوبة استعمار هذه البلاد عسكريا، فالعرب لا يطيقون رؤية أعدائهم على أرضهم جاثمين على صدورهم لما لهم من تمسك متين بثوابتهم القومية والعقدية وقدرة عالية على التحدي، فانتقل الغرب إلى تطبيق إستراتيجية جديدة محصلتها استبدال الاستعمار العسكري المباشر بآخر سياسي وثقافي مبطن بغطاء وطني، وبخبرتهم صنعوا قيادات محلية إن لم تكن عميلة فموالية لهم يتعاملون معها في كل جزء وطوعوا هذه القيادات ودربوها على طاعتهم والخنوع لسيطرتهم وتنفيذ أوامرهم وخططهم. وتقصدوا منح أحد الأجزاء استقلاله شكليا يدار ظاهرا بشخوص وطنية ويبقى واقعيا تحت وصايتهم ونفوذهم، حتى إذا كرس استقلال تلك الدولة تحت علم وقائد ودستور وحدود وسيادة مصطنعة، منحوا الجزء التالي استقلاله تحت قيادة أخرى مختلفة، فقسموا البلاد بالتتابع تحت قيادات موالية تنفيذ سياسات المستعمر الجديد، يضع لهم الخبراء الخطط وهم ينفذون السياسات الإستراتيجية، فسوريا ولبنان في أسيا وتونس والجزائر في أفريقيا تحت سيطرة فرنسا وبقيت حتى بعد الاستقلال على ارتباط وثيق بسياسات فرنسا وثقافتها، والعراق والأردن وعدن وفلسطين ومصر والسودان والخليج تدين لبريطانيا بالولاء السياسي والثقافي، وليبيا تحت سيطرت إيطاليا، ولكي يقضوا على كل حلم للعرب بالوحدة التي كانوا يتوجسون منها الخوف والرعب. ابتدعوا لهم ما أطلقوا عليه جامعة الدول العربية بديلا عن دولة الوحدة لتكون منصة يؤجج العرب في محافلها ومنتدياتها خلافاتهم ونزاعاتهم وتصبح مدعاة للتباعد والتنابذ والفرقة أكثر منها طريقا للتآخي والتعاون والتماسك.
كانت معاناة العرب بفعل وراثة تراكمات الفترة المظلمة التي مروا بها بعد سقوط الخلافة العباسية واستمرت ستمائة سنة لم يتول خلالها القيادة زعيم من أصل عربي معاناة قاسية، تفاقم فيها الفقر والجهل والمرض وانتشرت الأمية واتسعت الفجوة بين الفصحى واللهجات العامية المحلية، وسلكت دول الاستعمار الأوربي الحديث خطة إستراتيجية طويلة الأمد لإبعاد اللغة العربية وثقافتها عن حقل الإدارة والواقع العلمي والعملي الرسمي في الدول التي خضعت للانتداب، حتى بعد الاستقلال بهدف إيجاد فجوة بين اللغة العربية الفصحى وميادين الحقول العلمية والعملية والإدارية، فحصروا استعمال اللغة العربية في زاوية ضيقة تقتصر على التواصل الاجتماعي اليومي باللهجة المحلية، إمعانا في زيادة الجهل وإضعاف قيم الأمة وثوابتها، ولتنفيذ خططها الخبيثة في هذه المرحلة عملت من خلال خبرائها ومستشاريها في كل وزارة على جعل العرب يعولون على تأهيل نوابغ الطلبة بالابتعاث إلى الجامعات الغربية للدراسة وليشاهدوا الفرق بين تخلف بلادهم وتقدم الغرب فينبهرون بثقافة الغرب ويوالونه ويحرصون على مجاراته وملاحقة حضارته في كل شيء بعد عودتهم إلى أوطانهم، وبالفعل عادوا واحتلوا وظائف الدولة المهمة وبدأوا بتطبيق المناهج الغربية ونشر ثقافتها وأقصوا الثقافة القومية، ودخلوا في صراع مع المحافظين على الإرث الثقافي، وكانت لهم الغلبة بفضل السلطة والنفوذ والدعم الخارجي والإمكانات التي وضعت تحت أيديهم، فجعلوا منا مستهلكين لما تنتجه ثقافتهم ومصانعهم وسوقا استهلاكية لبرامجهم ومناهجهم، وأصبحت البلدان العربية الحديثة الاستقلال لا تقتصر على استيراد الثقافة بل تستورد منهم كل احتياجاتها بما فيها الحبوب والخضار مع ما لديها من انهار وأراض صالحة للزراعة، وبسبب شيوع الأمية ازدادت اللكنة المحلية فلهجة السوري غير المصري والعراقي، ولهجة اللبناني والأردني غير الخليجي، وشاع نظم الشعر الشعبي على حساب الشعر العمودي ولغة الفصاحة والبيان، ويبقى للحديث صلة.
بعد نحو قرن من اكتشاف النفط في المشرق، نسمع من يقول أصبح نقمة لا نعمة، فرق العرب إلى أغنياء وفقراء، وفتح عيون الغرب علينا لنصبح حلبة لصراع الأقوياء، أيهم يغرس بيننا الشر والبلاء، لتتحكم شركاتهم بأمورنا، فبالآليات والمرافق العملاقة والأيدي الفنية العاملة باستخراجه وتصديره تستحوذ على مقاديرنا، ففي العراق استخرج النفط 1925 وكانت حصة العراق من عائدات التصدير 10% فقط، بينما تتقاسم فرنسا وبريطانيا وأمريكا 72% منها، و13% لتركيا و5% للوسيط ألأرمني ومؤسسته كولبنكيان، فحين يصل الجشع والطمع بالغرب إلى حد الاستخفاف بالملكية وحقوقها وامتصاص دماء الشعوب، هل يؤمن كيدهم وتآمرهم على القيم المعنوية إذا كان التآمر يخدم هيمنتهم، فكل قيم الأمة وثوابتها أبيحت واستهدفت وبخاصة اللغة.
تطلب استخراج النفط إقامة موانئ لتصديره، ومطارات لسفر العاملين الأجانب، وبنوك لإيداعاتهم وتحويلاتهم ومستشفيات أقيمت لهم بأموالنا وتديرها كوادر أجنبية فسيطروا على المراكز الحساسة، ولا يوظف لديهم إلا من أجاد اللغة الأجنبية ووالى الغرب، وافتتحوا كليات الطب والهندسة في ثلاثينيات القرن الماضي وكل عمدائها ومدرسيها أجانب يدرسون باللغة الأجنبية فاتجه الشباب نحو تعلم اللغات والمدارس الأجنبية للحصول على البعثات الدراسية، وضمان مصدر رزق كريم، واقتصر تدريس العربية على الكليات الإنسانية كالآداب والشريعة الإسلامية والقانون، ففصلوا بين تراث الأمة وحاجات واقعها العملي والعلمي، وتضاءل دور العلوم الإنسانية وأصبحت اللغة العربية لغة الفقراء المعدمين والمتخلفين، وبدأ عدد المدارس الأجنبية الخاصة يضاهي عدد المدارس الرسمية ولاسيما في دول الخليج العربي الغنية.
وكان للثورات الوطنية بمنتصف القرن العشرين مصر والعراق وسوريا والجزائر دور إذكاء الروح القومية بالشعارات والخطابات، فاستبشر المعنيون بشأن اللغة خيرا بالقيادات الشابة وتوجهها القومي، ونمت حركة تعريب التعليم في الجامعات، واستطاع عبد الناصر بمساعدة دول عدم الانحياز إلقاء أول خطاب لزعيم عربي باللغة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960واصبحت العربية ضمن اللغات العالمية الست في المنظمة الدولية 1974، بيد أن اندفاع الضباط الذين تولوا القيادة بدأ يخفت ويتراجع حماسهم القومي ولم يكن لديهم خيار.. إما الخضوع للضغوط الأجنبية والحفاظ على كراسيهم أو مواجهة التأمر والسقوط فخضع، من خضع وسقط من سقط.
وأصبحت الشعارات وعودا في الخطابات السياسية والمناسبات، ولم يترجم القرار الدولي باعتماد اللغة العربية سادس لغة عالمية إلى واقع عملي على المستوى السياسي والثقافي، فالمفكر والمثقف العربي مهان في وطنه ليس له حصانة ولا كرامة ولا يستطيع التنقل من دولة إلى أخرى بحرية ما لم يحمل جنسية دولة أجنبية، ولا يعتد بثقافته وشهادته إن لم يتخرج في الجامعة الأمريكية، فمنهم الوزراء والأمراء وذوي الشأن في الحل والربط، ولا قيمة لمثقف لم يطعم لغته بكلمات إفرنجية، وحتى من لا يجيد لغة أجنبية صار يتبرج نفاقا بإيراد كلمات أجنبية ليوحي بأن خبراته معمدة بمعرفة اللغة الأجنبية. والأدهى أصبح علماء الدين ومحبو التراث يعلمون أولادهم منذ الصغر بمدارس أجنبية تكون العربية فيها على الهامش ويفضلونها على المدارس الرسمية، ولا يبالون بما يدفعون من أجور خيالية فيهدمون لغتهم بأموالهم، فما مستقبل اللغة العربية وهذا حال أبنائها الغيارى عليها؟العربية تواجه اليوم تحديا يهدد مستقبلها في عقر دارها، ويدرك العارفون أنها تعاني أوضاعا سيئة من التهميش والإهمال مما يستدعي الحريصين المبادرة للحفاظ على هوية الأمة وأمنها والتصدي لمخاطر تجاهل مشكلات الضعف المرتبطة بدعاوي العولمة وهيمنة القوى الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من ضعف عربي داخلي اهتزت له بُنى المجتمع الأساسية وثوابته العقائدية، وبات أبناء الأمة يتطلعون إلى غيرها في مجتمع المعلوماتية، وعجزت المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية ومؤسسات البحث العلمي ووسائل النشر عن الوقوف بوجه الهجمة الخطرة على اللسان العربي، ووقف التدهور الذي أصاب حصاد لغة الضاد، وبخاصة على مستوى مؤسسات الإعلام الإلكتروني ووسائل الاتصال فلم يعد بإمكان احد منع أبنائه القصر عن متابعتها والانثقاف بما فيها، وأصبحت أحاديث الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم وتجمعاتهم، فضلا عن فقر التدريس والتعليم الجامعي فعم الضعف دور العلم ومؤسسات الثقافة والمساجد والسوق والشارع والبيت، ولم تعد اللغة العربية تمتلك وسائل المقاومة والتصدي وليس لها غير الاستسلام وانتظار ساعة النفوق!
أضحت لغة الأمة في خطر. ولا مبالغة إذا كانت لغة الأمة في خطر فأمنها في خطر، اللغة ليست أصواتا وكلمات وجملا، اللغة مكون أساسي ثابت، وأهم مقومات الوجود والهوية، حاضر اللغة العربية ومستقبلها اليوم مرهون بما تتعهد به القيادات، من جهد لتدارك الانحدار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمنهج مدروس، وهمة جماعية، وحزمة قرارات عليا تلزم الجميع بالتعامل مع اللغة العربية على أنها اللغة الرسمية الأولى على الصعيد المؤسساتي والاجتماعي، ولنا عودة.
ليس بيننا من لا يشعر بالمأزق الحرج الذي تعيشه العربية، والخطر الداهم الذي تواجهه لغة للأمة، ولا مبالغة في القول متى كانت لغة الأمة في خطر فأمنها في خطر، اللغة مكون أساسي ثابت، وأهم مقومات الوجود والهوية، حاضر اللغة العربية ومستقبلها اليوم مرهون بما تتعهد به القيادات، من جهد حميد لتدارك الانحدار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفق منهج مدروس، وهمة جماعية، وحزمة قرارات سياسة عليا تلزم الجميع بالتعامل مع اللغة العربية على أنها اللغة الرسمية الأولى على الصعيد المؤسساتي العلمي والثقافي، لوقف التدهور الداخلي للمجتمعات التي لم يعد يمكنها مقاومة هذا الغزو الخطر لتطور تقنيات الاتصال والمعلوماتية، فلقمة العيش الهنية، وزهو الحياة البراق، وإغراء التكنولوجيا الحديثة يستهوي الشباب ويشدهم إلى تعلم اللغة الأجنبية والتعلق بها منذ الصغر وهنا مكمن الخطر.
ومن الطبيعي أن يمهد تعلم اللغة لاكتساب التقاليد أهلها، فاللغة في غنجها ونبرها في الجد والغضب، ورقتها في الهزل والطرب ترافقها حركات جسدية وقسمات تنعكس على المتحدث، فهناك تناغم قوي بين أداء الأصوات وأداء الحركات، وهنا مكمن الخطورة التي تستوجب وقفة حازمة على مستوى المسؤوليات والقيادة لتلافي فرنجة شبابنا وتغريبهم داخل أوطانهم، واستعادة ثقتهم بأنفسهم وثوابت أمتهم.
وقد لا يصدق الكثيرون أن مظاهر ضعف وتخلف العرب تعود إلى ضعفهم اللغوي، وأن اللغة معادل موضوعي للفكر، والإنسان في وجوده على سطح الأرض لا يختلف عن الكائنات الحية من اصغر حشرة إلى الفيل، كلها تمتلك ما يمتلكه الإنسان من أجهزة هضمية وتناسلية وعصبية وغيرها، الفرق الوحيد بين الإنسان والحيوان في النطق، ولقد عرفت بعض المصادر الإنسان بالحيوان الناطق، والنطق مهد للإنسان اكتشاف التفكير، فتطور جهازه العقلي، وبقيت سائر الحيوانات بعقل محدود، فنحن البشر نفكر لأننا نتكلم، وسائر المخلوقات لا تفكر مثلنا لأنها لا تتكلم. وإذا كانت اللغة أعظم نعمة ربانية، فاكتشاف الكتابة ثاني أعظم انجاز إنساني بعد اللغة لان الكتابة حفظت العلم والحضارة، وعلى الإنسان أن يبدأ من حيث وصل أسلافه، ولولا اللغة ما كانت الكتابة ولا كان الفكر.
التفكير لا يكون إلا باللغة، فمن كانت لغته سليمة صحيحة كان تفكيره صحيحا وسليما، وسر تقدم الأمم بقوة لغتها، وتقدم العرب على سائر الأمم يوم كانت لغتهم قوية، وضعفت دولتهم يوم ضعفت لغتهم، فالأمم تتقدم بلغتها لا بلغات غيرها، تقدمت اليابان وأبدعت ولم تعلم أبناءها العلوم باللغات الأجنبية على حساب لغتها، وتعلم الصينيون العلوم بلغتهم وأبدعوا ولم يكونوا بحاجة إلى التعلم باللغات الأجنبية، ونحن لا ندعو إلى الكف عن تعلم اللغات الأجنبية، الحديث الشريف يقول: “من تعلم لغة قوم أمن مكرهم” ديننا يشجع على تعلم اللغات، ولكن تعلم اللغة الأجنبية ثقافة، غير تعلم العلوم باللغات الأجنبية، من يتعلم العلوم بلغة قوم يبتكر لهم ولسد حاجاتهم، فنمط تفكير كل أمه مرتبط بطبيعة لغتها وحاجاتها.
لقد برع العرب بعلوم الطب والفلك والرياضيات وازدهرت لديهم العلوم والمعارف حينما كانوا يجيدون لغتهم ويميزون بواسطتها بين دقائق الأمور، وتوقف الإبداع والابتكار حينما ضعفت لغتهم. من يتعلم في الغرب ويتقن لغتهم أكثر من لغته الأم يبدع للغرب ولسد حاجاتهم، وهذا سر فشل بعض أبنائنا حينما يعودون للعمل في بلادهم ورغم تفوقهم بدراساتهم في الغرب، لا ينجحون في حياتهم العملية فإذا عادوا إلى الغرب ثانية وجدوا أنفسهم يبدعون ويبتكرون وينجحون أكثر مما كانوا ببلادهم، والسر من يتعلم بلغة يعمل بها، فنحن نعمل بأيدينا بوحي من تفكيرنا، ونفكر بوحي من عمل أيدينا، والتفكير لا يكون إلا باللغة. وأوائل النهضة العربية الحديثة وبداياتها تزامنت مع نهضة اليابان الحديثة، لكن اليابانيين اعتمدوا في سد حاجات شعوبهم على أنفسهم، وأصروا على أن يقتصروا في الاستهلاك على ما ينتجون، واستعانوا بلغتهم على التفكير بأولويات ما يحتاجون إليه، والحاجة أم الاختراع، فنجحوا وتقدموا، أما العرب فاختاروا طريق استقدام تقنيات الغرب فأصبحنا نستهلك ما ينتجه غيرنا وبقينا من غير إنتاج، وبقيت حاجاتنا الضرورية لم تشبع، فما يأتينا من الخارج لا يرضينا داخليا، وما يرضيا داخليا لا نجده في الخارج، وبقينا خارج النهضة وخارج الحضارة نلهث وراء الآخرين، لا نعرف إن كنا قدماء تقليدين في عالم متقدم، أم متقدمون في عالم متخلف!
وساعدنا اكتشاف النفط في الحصول على العملة الصعبة فاستسهلنا الاستيراد على العمل بأيدينا ووفق ما نفكر ونتكلم، واستمرأنا الأشياء الجاهزة المعلبة، وهكذا استقدمنا معدات الحضارة الغربية وكوادرها العاملة وبقينا تحت رحمة أيديهم، وعلينا أن نتقن لغتهم لنتعامل معهم كمساعدين، هم يمتلكون أسرار العمل فهم القادة الميدانيون ونحن الجند، وعلى الجندي أن يتبع القائد.
إن سياسة الاعتماد على الخارج في استيراد كل ما نحتاج إليه، جعل منا امة مستهلكة، فنحن نتعلم اللغة الأجنبية للاستهلاك المحلي وليس للإبداع، فلم تستطع الغالبية إجادة اللغة بالدرجة التي تسمح لهم بالإبداع والابتكار والاختراع، وبقي الإنسان العربي يدور في إطار العمل الثانوي المساعد، وفق ما يراد منه وليس ما يريد ويفكر، فتوقف عن منافسة الأجانب المشروعة أو مشاركتهم الإبداع، ورضي بالمراوحة ضمن الكادر الثاني، واحتل الأجنبي الكادر القيادي الأول محتفظا لنفسه بالقدرات الإبداعية ومهارات التطوير، فسيطرت علينا عقدة الخواجة، باعتباره العقل المدبر الأول دائما، وينشرح صدر الأجنبي فكيفيه منا أن نكون كادرا وسطيا للتواصل مع الآخرين كالسلك الكهربائي يوصل التيار ولا يعلم ما ماهيته، ولا نشارك على أمل أن نحل محله أو نرتقي إلى مرحلة أعلى، وهكذا أصبحنا كالغراب الذي رأى مشية الحمامة فأعجبته وأراد أن يتعلمها فعسر عليه وأراد العودة إلى مشيته الأولى فنسيها وتعثر.
ونحن أضعنا التفكير بالغة الأجنبية ولم نعد قادرين على التفكير باللغة العربية لضعف تكويننا فيها، وزيادة في التردي آثر شبابنا العمل المكتبي على العمل الفني، واعتمدوا في أداء الأعمال الفنية على الأيادي الأسيوية الرخيصة وآثروا الراحة والأبهة تاركين للأجانب الجمل بما حمل، وصار أرباب العمل يفضلون العمالة الأسيوية على العمالة العربية، فمواصفات العامل الأسيوي في الحرص والطاعة والسكوت والرضا بالقليل وتقبل التأنيب أسهل قيادة، تجعله مفضلا على نظيره العربي، فازدحمت شوارعنا بالأجانب، وأصبح من العسير استخدام اللغة العربية في الأزقة والورش والبردات.
أما في البيوت فمن الصغر يتعلم أبناؤنا على لي لسان الفطرة مقلدين الشغالة الآسيوية وهي ترطن، فمن أين للغة العربية أن تنهض وأبناؤنا يرضعون من الأسيويات هجنة اللغة ولكنتها ولحنها من الطفولة؟ لقد أصبح هوس التعلم باللغة الأجنبية عبئا ثقيلا على مجتمعنا، وقضى على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأذكياء والأغبياء، الأغنياء والفقراء، ويوهم نفسه من يقول يوجد تكافؤ فرص ولاسيما في الخليج، فالأغنياء يدرسون ويتعلمون اللغة في المدارس الخاصة ويدفعون أجرا خياليا لا يقوى على دفعه الفقراء ولا متوسطو الحال، وبالنتيجة بات خريجو المدارس الرسمية يواجهون صعوبات عند انتقالهم إلى الجامعة، فمن شروط قبول الجامعات لطلبتها إجادة اللغة الأجنبية واجتياز امتحان القبول، ومن لا يمتلك مستوى جيدا لا يستطيع مواكبة اقرانه لضعف لغته الأجنبية ويواجه الإخفاق. صارت دراسة اللغة الأجنبية وإجادتها هي الهم الأول والهدف قبل العلم، على حساب تخلف اللغة العربية. حتى أساتذة الجامعات صاروا مؤسسين وفق القالب الأجنبي واللغة الأجنبية، ولو طلب منهم التدريس باللغة العربية لتلكئوا، ولتعذرت عليهم حتى الترجمة لقصور لغتهم العربية. وأصبحت الجامعات الخاصة لدينا تدرس مادة اللغة العربية التي هي مقرر واحد للطلبة باللغة الانكليزية، يتعلم فيها الطالب تاريخ اللغة وخصائصها العامة، كما يدرس الطالب البريطاني مقرر اللغة العربية في بلاده لو وجد كثقافة عامة.
وهكذا استمر وسيستمر التدهور الداخلي للغة المجتمع وستتفاقم وتشتد أكثر مستقبلا، نحن لم نعد نعاني مرض ضعف اللغة وإنما إعاقة اللسان العربي، ولم يعد المجتمع المدني بمفرده قادر على مقاومة هذا التدهور الخطر، الذي استفحل واستمكن واستحكم، نحن اليوم في البلاد العربية وفي الجزيرة والخليج على وجه الخصوص، موطن البداوة التي كان العرب يأخذون من أهلها لسان الفصاحة والبلاغة مشافهة ويرضعونها بكرا، لا يستطيع اليوم من يجيد اللغة العربية ولا يجيد غيرها مراجعة المستشفى والمصارف، والفنادق والمرافئ والمناطق السياحية، ولا يستطيع التعامل في الشارع العام أو السؤال والاستفسار عن مقصده، أو حتى يشتري ويبيع بيسر من دون أن يلوي لسانه بحسب محدثه، صار علينا أن نتعلم لغات القارة الهندية المحلية بلهجاتها المختلفة وغيرها من اللغات الأسيوية قبل أن نتعلم العربية، حتى الشغالة التي تخدم في البيوت نحدثها بلغتها ولا تتعلم لغتنا، وهناك من يشترط إجادتها للغة الإنكليزية، ليتعلم منها الأولاد الصغار الانكليزية جيدا والعربية المكسرة بحكم المعايشة طيلة ساعات اليوم بعيدا عن الأبوين، هناك تغريب ديموغرافي للوجوه والأزياء والعادات والتقاليد واللسان، أصبح الوجه العربي واللباس العربي واللسان العربي غريبا في بلادنا. وفي دبي والإمارات وقطر ومناطق حيوية مهمة يمر عليك اليوم والأسبوع والشهر ولا تفلح بلقاء رجل من أهل البلد، ولم يعد اليوم بمقدور أي إنسان من أهل البلد أو من خارجه، مهما كانت صنعته أن يجد عملا ما لم يكن يجيد اللغة الأجنبية، بل ويشترط مسبقا من المتقدم للعمل إجادة اللغة الإنجليزية مثلا قبل الخبرة كما لو كان العمل في بريطانيا وليس في بلد عربي. والله المستعان على ما يصفون.
معاناة اللغة العربية اليوم ليست وقفا على دولة دون أخرى، ولا شعب دون آخر، البلاد العربية من المحيط إلى الخليج تعاني المأساة التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم، وتبدو أكثر إلحاحا في الخليج والجزيرة، وقد وصلتني تعليقات عديدة على النت ترى أن تشخيص المشكلة يسيرا، والكلام عنها سهل، ولا يحتاج إلى مزيد من الأدلة، ولكن المعضلة في الحل، أين؟ وكيف؟ ومتى؟ وتطلب توصيف علاج ناجز، وهو اعتراض وجيه في محله، وفي رأينا: إن أول خطوة نحو علاج ظاهرة ضعف توظيف اللغة العربية في موطنها تبدأ من تشخيص الإشكالية وتوصيفها، بحيث يقتنع غالبية أبناء الأمة إنهم مسئولون مباشرة عن هذا الضعف، وإنهم جزء من المشكلة، وجزء من الحل، ومتى شعر أبناء الأمة ولاسيما القادة والمفكرون والمثقفون وذوي الاختصاص بالذنب، وأن عليهم أن ينبروا بجدية ويتأهبوا لخوض معركة جماعية ضارية مع التخلف، يصبح الحل ممكنا مهما بدا عسيرا.
الأمة كلها ينبغي أن تستوعب المشكلة، وتشترك في صنع القرار عن إيمان ومصداقية ودوافع ذاتية، فدولة واحدة أو اثنتين لا تستطيع النهوض بهذا الأمر الجلل، القرار بيد الدولة ويؤخذ على مستوى القمة، وعلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أن تشترك في بحث الإشكالية وعمل خطة موحدة إستراتيجية لعشرين عاما يتبناها مؤتمر القمة العربية، وترصد لها أموال، وتتفرغ لها لجان ومؤسسات ترتقي إلى مستوى الوزارات تحمل المداس والجامعات والمؤسسات التعليمية على تنفيذها، وفق برامج ومناهج مدروسة، وإشراف دقيق بدءا من السنة أولى ابتدائي حتى التخرج من الجامعة، فبناء اللغة لا يقتصر على مرحلة وإنما يشمل كل المراحل.
وعلاج الإشكالية باعتقادنا يقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى إعداد المعلم المتخصص بتعليم اللغة العربية إعدادا رصينا يناسب كل مرحلة، فلابد أن يعد معلم متخصص بتعليم الجيل في السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي الابتدائي، وآخر خاص بمرحلة الثلاث سنوات التالية، ويعد مدرس لطلبة الإعدادي وآخر للثانوي، فكل مرحلة تتطلب طبيعة خاصة وتدريب مختلف، وليس مدرس لغة عربية فحسب. والركيزة الثانية أن نكون على يقين وإيمان بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فإرادة التغيير إن كانت هناك إرادة تبدأ من اللغة، وقد استمدت اللغة العربية قوتها من القرآن الكريم معجزة رسولها الذي بث في جسدها وروحها الحياة والقوة، لا أقول هذا من منطلق أيديولوجي، وإنما من منطلق لغوي بحت، القرآن نشر لغة الأمة، ووحد وقرب بين لهجاتها، وفتح لأهلها آفاق التفكر والتدبر والتأمل، وصانها ويصونها في المستقبل، ويجب العودة إلى القران الكريم ونعلم أبناءنا قراءته وترتيله وضبط تشكيلاته منذ الصغر، ومعرفة معاني مفرداته وصوره البلاغية وشواهده النحوية، وما لم نبدأ بتقويم لفظ الأجيال من مخارج الحروف إلى تشكيلها كما نطق الأوائل، لن نستطيع تدارك الوهن الذي أصابها، وما لم يتقن الطالب قراءة القرآن الكريم ترتيلا ونطق مفرداته وتراكيبه بصورة سليمة وصحيحة على يد مربين يعدون إعدادا جيدا وإدراك معانيه وتفسيره وتأويله ، قبل أن ينهي الطالب مرحلة الثانوية العامة، لن يكون البناء سليما وقادرا على النهوض والتأسيس للنهضة التي نتطلع إليها، فما ضعفت لغتنا إلا بعد أن ابتعدنا عن القرآن الكريم وأصبح 99 % من المتعلمين وخريجي الجامعات لا يجيدون قراءة ثلاثة آيات على بعضها بصورة سليمة وصحيحة. إن قراءة القرآن تفتح ذهن الطالب ومداركه على ثقافة واسعة منذ الصغر يقرأ النكاح والطلاق والحيض والأرحام والحلال والحرام والحدود فيكتسب ثقافة عامة واسعة في شؤون الحياة. ويدرك أهمية العلم والعقل وما أكثر الآيات التي تنتهي بمفردة يعقلون، ويتدبرون، ويتفكرون ومرادفاتها.
أما الخطوات الإجرائية فدورها ثانوي، فهي تؤخذ لتعضيد المسار، كتعريب المناهج، وزيادة ساعات تدريس اللغة، وجعل دراسة النحو والصرف في مقرر منفصل عن مقرر الأدب والبلاغة والنقد، ولابد من العناية بجماليات اللغة كتدريس الخط العربي، والأمثال والحكم، وحفظ روائع الشواهد، وتشجيع البحث العلمي، وزيادة حصة اللغة الفصحى في وسائل الإعلام، وتنشيط البرمجة والمعلوماتية باللغة العربية، واستخدامها في مراسلات المؤسسات العامة والخاصة الرسمية وشبه الرسمية، وتشديد الرقابة على العناية بسلامة الصياغة، وحمل الأجانب على تعلم لغة الدولة التي يعملون فيها واحترام أهلها، وربط حصول الأجنبي على الإقامة والعمل باجتياز اختبار مستوى بعد ستة أشهر من وصوله، واجتياز اختبارات مستوى جديد لاحقا، وما أسهل أن يتم خلال سنتين أو ثلاث تعريب ألسنة كل الوافدين لو شئنا بصدق ذلك وبقرار من وزير العمل. ولسنا في مجال من يضع خطة ولكنها خطوط عامة ووجهة نظر وحسبنا الله ونعم الوكيل.
.د.عمران الكبيسي
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة rss_net في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-18-2021, 08:19 PM
-
بواسطة عامر العمار في المنتدى مكتبة الادب والثقافة وعلوم اللغة والتربية
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 02-13-2021, 09:27 PM
-
بواسطة كاظم المسعودي في المنتدى منتدى التاريخ العراقي لمختلف العصور
مشاركات: 10
آخر مشاركة: 01-30-2021, 10:07 PM
-
بواسطة ماجد الجبوري في المنتدى منتدى التاريخ العربي
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 01-30-2021, 10:06 PM
-
بواسطة عامر العمار في المنتدى منتدى قرأت لك
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 03-07-2018, 10:00 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
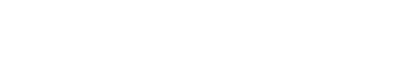








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات