-
 الدولة العربية الحديثة ومأزق الانكشاف الوظيفي والاستراتيجي
الدولة العربية الحديثة ومأزق الانكشاف الوظيفي والاستراتيجي
تقديم ومنهج
إنَّ ما تشهده الساحات العربية اليوم من حركات إحتجاجية وثورات متنقِّلة من قِطر إلى آخر يكاد يكون ظاهرة لم يسبق لأي منطقة في العالم أن شهدتها، سواء من حيث التزامن وسرعة التفاعل العابر للحدود السياسية لغير دولة عربية من جهة، أم من حيث الشعارات المرفوعة المنادية بإسقاط الأنظمة الحاكمة، وصولاً إلى تغيير جذري في وظيفة الدولة، وإعادة تصحيح علاقتها المختلة بمجتمعها من جهة أخرى.
إنَّ الملفت في الحركات الحالية هو خروجها عن آليات التغيير العربية التقليدية التي طبعت التاريخ العربي المعاصر بخصوصيتين بارزتين: الأولى، لاعتمادها الانقلابات العسكرية، والثانية لكونها مدبَّرة في بلاطات القصور الحاكمة بهدف الاستئثار بالسلطة. فالشعار المركزي الذي ترفعه حركات اليوم يتمحور حول إعادة صياغة الدولة لجهة بنيتها المدنية الديمقراطية من جهة، وعدالتها التوزيعية بما يستجيب لحاجات مجتمعها بكل فئاته الاجتماعية والسياسية وشرائحه في التنمية المستدامة والتطوّر الديمقراطي من جهة أخرى.
لقد كثرت تحليلات الأسباب الكامنة وتفسيراتها وراء تلك الاحتجاجات، فالبعض، من زاوية الاستسلام لنظرية المؤامرة، يعزوسخونة المشهد العربي الراهن إلى مخطط أجنبي أميركي– أوروبي، بوجه خاص، يهدف إلى إنتاج جغرافية سياسية شرق أوسطية جديدة تنتفي معها أنظمة الحكم القائمة، والاتيان بأنظمة بديلة تؤسّس لعلاقات إنتاج تسمح، ليس فحسب بتطوير القوى المنتجة المحلية، وإنما أيضًا بتوفير مناخات ملائمة لنمو الرساميل والاستثمارات الشركاتية العابرة لحدود الدول السيادية في عصر العولمة الراهن. أما البعض الآخر فيرى في إخفاق مشروع الدولة العربية الحديثة وتعثّر وظائفها، على أنه يتقدّم سائر الأسباب الأخرى الدافعة إلى مثل تلك الاحتجاجات والثورات المتواصلة في غير ساحة عربية.
صحيح أنَّ مشروع الغرب الرأسمالي في السيطرة على المنطقة العربية وثرواتها، وفي توفير الأمن للكيان الاستيطاني الصهيوني وحمايته، هو مشروع ثابت إستراتيجيًا في السياسات الغربية الخارجية، إلاّ أنَّ الصحيح أيضًا أن هناك ثمة إخفاقًا في مشروع الدولة في النظام الإقليمي العربي، هذه الدولة التي ما زالت، منذ نشأتها كاجتماع سياسي، تعاني اختلالات بنيوية عميقة طالت مختلف هياكل البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديمغرافي والثقافي.
تسعى هذه الدراسة إلى توصيف موضوعي لأزمة الدولة في النظام الإقليمي العربي بدءًا من تحليل الأسباب الحاملة التي حالت، حتى الآن، دون نجاح تجربة هذه الدولة وأبقتها بالتالي، في دوَّامة التعثُّر والإخفاق، مرورًا بتعيين الاختلال الوظيفي والانكشاف الاستراتيجي على غير مستوى إجتماعي وإقتصادي وسياسي وثقافي وتنموي.
أما بشأن المنهج المعتمد في هذه الدراسة فهو المنهج الكلي التحليلي الذي يسعى إلى قوننة الظاهرة التاريخية والاجتماعية أي إخضاعها لقانون يحكم مسارها منذ توافر أسباب نشوئها وتشكلِّها، مرورًا بالمسارات التي تسلكها في المكان والزمان المعينين، وصولاً إلى النتائج التي تتركها في الواقع الراهن، أو تلك المتوقّعة التي يمكن استشرافها مستقبلاً. مع هذا المنهج لا يبدو أن استشراف المستقبل مسألة عصيَّة على الحسبان أو التوقّع، أو أنه أمر يبقى خارج قدرات التحليل التاريخي الاستراتيجي، وإنما هو منهج تعزّزه رؤية أكثر شمولاً، وأبعد عمقًا، تمزج بين علوم التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة.وتضع الجميع في إطار من الصيرورة الحضارية العامة أو الرؤية التاريخية الفلسفية التي تتعامل مع المستقبل في سياق زماني أوسع قد يمتد إلى الوراء قرونًا حتى يستطيع الباحث أن يمدَّ البصر إلى الأمام عقودًا) (1).
النظام الإقليمي العربي: خصوصيات التشكّل المشترك
تأسيسًا على منهج الربط بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية التاريخية، أي الربط بين المكان والحدث، فإن الجغرافية العربية هي عبارة عن مجال طبيعي بشري إجتماعي إقتصادي وسياسي يمتدّ من الخليج شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى البحر الأحمر فالمحيط الهندي جنوبًا.
تصل المساحة المترية لهذا المجال إلى حوالى 13.6 مليون كلم2، تُقيم عليها كتلة سكانية قدِّرت العام 2010 بحوالى 335 مليون نسمة (2) وهي موزّعة على وحدات سياسية (دول) ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في إطار منظّمة إقليمية هي جامعة الدول العربية تضمّ حاليًا في عضويتها إثنين وعشرين كيانًا سياسيًا بما فيها السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان التي أعلنت انفصالها عن دولة السودان المركزية مؤخرًا.
يحكم المجال العربي المشار إليه وحدة النظام الإقليمي من حيث تشكّله التاريخي العام. أما أبرز خصوصيات هذا التشكُّل فإثنتان أساسيتان(3):
الأولى: وحدة المدى الجغرافي الذي هو عبارة عن منطقة جغرافية تتميّز بالتواصل من جهة، والتكامل البيئي من جهة أخرى. فهذا المدى لم يعرف الحدود السياسية الفاصلة بين مناطقه إلا في مرحلة ظهور الدولة الحديثة، وهي الدولة التي نشأت في ظلّ السيطرة الأوروبية في محاولة مكشوفة للتجزئة السياسية، والحؤول دون توحّد المجال العربي في دولة واحدة تعكس قيام الدولة – الأمة أو الدولة القومية على غرار النموذج الغربي للدولة التي تلازم ظهورها مع الثورة الصناعية وسيادة الرأسمالية كنظام إنتاج يقوم على المراكمة المستمرة.
الثانية: كثافة التفاعل بين وحدات هذا النظام الإقليمي وكل تلوينات هذا التفاعل والحرارة التي يولّدها، إضافة إلى السرعة التي يجري فيها. شكّل هذا التفاعل العامل الأبرز في التكوين التاريخي الخاص الذي عرفته الأمة العربية عبر مراحل تطوّرها المختلفة. فقد ظهرت «العروبة» كأهم محدّد معياري لفكرة القومية العربية التي تمايزت، عن سائر القوميات، بخصوصيات تفاعلاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية. وبسبب العروبة ظهرت دعوات فكرية تدعو إلى الوحدة العربية يبن سائر مكوّنات النظام الإقليمي العربي، وقد عبَّرت عن نفسها في محطات تاريخية مفصلية على صورة مشروعات سياسية، وكذلك من خلال قيام عدة تجارب كان آخرها تجربة الوحدة المصرية–السورية (1958-1961).
وإذا كان لهذه الأفكار والمشروعات الوحدوية من دلالة فإنما تدل على «أنَّ الإيديولوجيات والأفكار تنساب بين الدول العربية من دون عوائق أو حواجز، كما تتبادل هذه الدول التأثيرات السياسية في ما بينها»(4).
إنَّ حيوية التفاعلات العربية كانت بمنزلة الدافع الأقوى الذي وقف وراء كثرة المشروعات الاتحادية التي قدّرتها إحدى الدراسات بـ95 محاولة بين 1913 و1987 أي بواقع أربعة مشروعات أو محاولات للتوحّد كل ثلاثة أعوام(5).
الدولة في النظام الإقليمي العربي
لم تظهر الدولة العربية الحديثة نتيجةً لتطورات ذاتية، وإنما كانت إستجابة لمشروعات السيطرة الأوروبية في إنتاجها جغرافية سياسية عربية تتوزّعها عدة كيانات سياسية – دول تأخذ مسارات متباينة من التطوّر، كل ذلك بهدف تعميق التجزئة من جهة، وإبقاء الدولة – الكيان في دوامة الإخفاق والعجز الوظيفي من جهة أخرى.
إنَّ رصدًا موضوعيًا للمسار التطوّري الذي سلكته الدولة في النظام الإقليمي العربي منذ قيام جامعة الدول العربية العام 1945 وحتى اليوم، يخرج بتسجيل إستنتاج قاطع مفاده أن الدولة العربية الحديثة كانت تتطوّر على قاعدة أزمة بنائية ووظيفية باتت معها غير قادرة على الخروج منها بسهولة. تمثّلت هذه الأزمة على مستويين: الأول، تعثّرها في إنجاز هياكلها المؤسسية الداخلية، والثاني، عجزها الوظيفي في إدارة مجتمعها من ناحية، وفي التوصّل إلى مصالحة مع مجالها القومي من ناحية أخرى.
حملت الدولة في النظام الإقليمي العربي مع الولادة، أسبابًا مزمنة لتخلّف توارثتها عن مجتمعها القديم. ولم تلبث أن تحوّلت إلى معوّقات ضاغطة لازمت قيام الدولة وأفقدتها القدرة على التأسيس لتجربة ناجحة تأخذ بأسباب النهضة ومراكمتها. أبرز تلك المعوِّقات إثنان: مشكلة الانتقال إلى مجتمع الدولة الحديثة من جهة، ومشكلة عدم دخول الدولة الحديثة في الوعي السياسي العربي من جهة أخرى.
المعوّق الأول: مشكلة الانتقال من الاجتماع السلطاني القديم إلى اجتماع الدولة الحديث
واجه إجتماع الدولة الحديثة في النظام الإقليمي العربي أزمة انتقال من إجتماع عصباني عثماني إلى إجتماع سياسي مؤسسي جديد في ظل دولة حديثة(6). فالمجتمع العربي، عرف لقرابة أربعة قرون متواصلة النظام المقاطعاتي العثماني، وهو نظام إعتمد المقاطعة كوحدة إدارية سياسية، على الرغم من عدم استقراريتها في خارطة التوزّع الإداري الذي شهد تغيّرات مستمرة، بحيث أن المقاطعة كانت تتسع أو تضيق وفق قوة المقاطعجية المسيطرة وقدرتها على سحب الفائض الاقتصادي على شكل ضرائب من القوى المنتجة الفلاحية والحرفية من جهة، وتجنيد الفرسان والمحاربين للخدمة العسكرية من جهة أخرى.
مع سقوط السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، إنتقلت البلاد العربية إلى سيطرة الدول الأوروبية في ظل أشكال مختلفة من الإنتداب والوصاية والحماية ولكنها واحدة من حيث سلطة مرجعية أجنبية حاكمة.
هذا الإنتقال كان ينطوي على أزمة في الإستيعاب لمفاهيم الدول الحديثة التي أرادت الدول الأوروبية إقامتها وفق نماذج الدول الرأسمالية في الغرب في استجابتها لمصالح الرأسمال في تحقيقه مراكمات ربحية مستمرة.
أفضت السياسات الأوروبية في إقامة سلسلة من الكيانات السياسية – الدول إلى تجزئة الجغرافية السياسية العربية، بحيث باتت التجزئة عاملاً رئيسًا حاكمًا لنشأة الكيانات والدول الحديثة. فقد إكتسبت هذه التجزئة، وما تزال، «أبعادًا إجتماعية وإقتصادية وسياسية وفكرية ومضامين خاصة تجلّت في بروز «نخب» ومؤسسات وهياكل إدارية، ومستويات من الإنتاج والاستهلاك، ومن المصالح الاقتصادية والانتماءات الوطنية– القطرية داخل كل دولة، وأصبحت هذه الأبعاد والمضامين معطيات فعلية وحقائق معاشة لا على مستوى أهل الدولة فحسب، بل على مستوى المواطنية والمواطنين أيضًا»(7).
قام مجتمع الدولة السلطانية على تعدّدية دينية وعرقية وإجتماعية وثقافية ومدنية أهلية جرى استيعابها عبر مؤسسات مختلفة كنظام الملل والأوقاف، والمجموعات القروية والعائلية والعشائرية والقبلية التي كان لها مجالسها وأمراؤها ومقدَّموها المحليُّون، وكطوائف الحرف وطرق الصوفية التي كان لها مشايخها ونقباؤها وتنظيماتها الخاصة.
إلا أن دخول المجتمع القديم عهد الدولة الحديثة أشعره بصعوبة استيعاب المؤسسات الجديدة كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والنوادي ومراكز الضغط والتدخّل وسائر تشكيلات ما اصطلح على تسميته في التجربة الغربية الحديثة بـ«المجتمع المدني»(8)، الذي شكّل قيامه خروجًا على السلطة الإكليريكية في القرن التاسع عشر، وأيضًا على الدولة العسكرية التوتاليتارية في القرن العشرين. هذا المجتمع المدني غير مفصول عن الدولة أو مناقض لها، بل هو مستقل عنها استقلالاً نسبيًا ومتفاعل معها في إطار علاقة تبادلية بينية عبر أطر جديدة من التفاعل الحر والحي، وعبر المشاركة الديمقراطية في إنتاج سلطة تمثيلية تلتزم ترجمة فعلية لميثاق إجتماعي أو بالأحرى لعقد إجتماعي ينظّم العلاقة المتوازنة بين المجتمع والسلطة أي بين المحكوم والحاكم.
هكذا أمام ضغط المجتمع القديم المخزون في وعي الجماعات والأفراد في غير بلد عربي، وهجوم المجتمع المدني بهياكله إستجابةً لحاجة تحديثية تتناسب مع مفاهيم المرجعية السلطوية الأجنبية الحاكمة وتقاليدها، وكان الصدام حتميًا بحيث ارتدت المواجهة بين التقليدي المحافظ والحداثوي المتطوّر طابعًا صراعيًا أبقى النظام العربي العام في حال من التعارك الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، ذلك أنَّ مرجعية المجتمع الأهلي المتعدّد في مرحلة الدولة السلطانية لم تعد مرجعية صالحة للتمثّل والتطبيق في مجتمع الدولة الحديثة، كما أن مرجعية المجتمع المدني الأوروبي، وكما يتمثّل في وعي بعض النخب العربية كنقيض للإجتماع الديني، وكحال قطيعة حضارية ومعرفية، لا تنمّ عن منهجية سليمة وصحية(9).
إنَّ انتقال المجتمع العربي من دائرة العثمانوية إلى دائرة الدولة الحديثة في ظل السيطرة الأوروبية والمرحلة الاستقلالية اللاحقة، إستمر مخزونًا ببنيته العثمانية لجهة طبيعة المجتمع الأهلي الذي ساد قرونًا في العهد العثماني، ولجهة أهلية المجتمع في تقسيماته الداخلية عشائر، مللاً ومذاهب، وأعراقًا، وتجمّعات حرفية، وطرقًا صوفية وما إلى ذلك من تشكيلات دينية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وسياسية لا متناهية.
لذلك، كانت الإشكالية التي واجهت هذا المجتمع الأهلي بولاءاته الأولية تكمن في صعوبة اندماجه في مجتمع مدني حديث سعت الدول الأوروبية المسيطرة لإيجاده كبديل للمجتمع الأهلي العثماني الذي بات معوِّقًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لعمل الدولة الحديثة، وحائلاً دون قيامها بوظائفها من أجل قيادة المجتمع ونهوضه وتطوّره.
المعوّق الثاني: الدولة الحديثة ظاهرة طارئة على الوعي التاريخي والسياسي العربي
شكّلت الثقافة القديمة المخزونة في وعي المجتمع الأهلي العربي أحد أبرز المعوّقات التي واجهت قيام الدولة الحديثة. فثقافة هذا المجتمع، وكذلك ثقافة النخب التي تبوّأت مقاليد السلطة وفق آليتها الأوروبية الوافدة (إنتخابات، دساتير، برلمانات، حكومات)، ظلّت ثقافة محكومة بنزعة المحافظة على البنى التقليدية المتمثّلة بالعائلة والجماعة الإثنية، والعشيرة، والطائفة وغيرها.
لم تستطع الدولة الحديثة أن تحدث انقلابًا ثقافيًا ومفهوميًا في بنية المجتمع القديم. فقد استمرت هذه البنية تمثّل العنصر الأبرز في المواجهة الصراعية بين المفهومين التقليدي والحداثوي، وهي مواجهة نالت وما تزال، من تطوّر الدولة الحديثة، ومن أدائها ووظيفتها في غير بلد عربي، الأمر الذي جعلها تختلف كليًا حسب «فاليرس» (Weulersse) عن مثيلتها في الغرب. ويزعم «فاليرس» أن ظاهرة «الأمة – الدولة» هي ظاهرة أوروبية لم يعرفها الشرق العـربي-الإسلامي، وكذلك فإن المسار التاريخي الذي عرفته الطبيعة الخاصة للسلطة والدولة في هذا الشرق العربي- الإسلامي هو مسار مختلف عن الغرب، وبالتالي، لا يمكنه إنتاج نموذج الدولة نفسه. فقد ظلَّت الدولة الغربية ظاهرة غريبة عن الفكر السياسي العربي عبر مختلف الحقبات والمراحل التاريخية. ففي رأيه «لم يحصل في الشرق هذا التدامج والتماثل التدريجي بين العناصر المكوّنة الثلاثة: الأرض، الأمة، الهيئة السياسية، والتي أدت إلى تكوّن بلدان أوروبا الغربية التي تعتبر فرنسا أكثرها نضجًا واكتمالاً. ففي الشرق بقيت الدولة ترتبط بالأمير، والدولة – الأرض هي مجرد تجاور مقاطعات تعود للأمير نفسه. وهذا التعريف يبقى ذاته إن كانت الدولة عبارة عن أمبراطورية إمتدت إلى القارات الثلاث، كما هي حال الأمويين والعباسيين ولاحقًا العثمانيين، أو كانت عبارة عن تكوين أصغر كما هو الحال مع المماليك، أو إن اقتصرت على مدينة واحدة وضواحيها». وعن طبيعة الحاكم يضيف «فاليرس» أنَّه»خليفة كان أو سلطانًا، أو باشا أو أميرًا، لا أهمية للّقب، يبقى المبدأ واحدًا: فالأمير وحده هو الذي يمثّل حقيقة الدولة، والتبعية للأمير وقومه تشكّل المنطلق(10)».
ويطرح «فاليرس» مشكلة الانتماء في المشرق العربي متسائلاً: «وإذا ما سألت فلاحًا من الجزيرة أو من المنطقة الشرقية من لبنان (Anti-Liban)، أو عجلتون من يكون؟ يجيبك أنه من هذه القبيلة أو تلك، أو من تلك القرية، يجيبك أنه مسلم، أرثوذكسي، أو درزي... لكن لا يجيبك بعفوية أنه عراقي، أو سوري، أو أردني. قد يقال إنَّ هذه دول حديثة وكيانات إصطناعية هذا لا شك فيه، ولكن أليس من المؤكّد أننا نحصل على النتيجة نفسها في حال ملاحظتنا للفلاح في مصر؟ هو أيضًا يجهل وطنه على الرغم من أنَّ مصر هي أكثر بلاد العالم تهيؤًا لإنتاج هوية وطنية(11)».
لا ينطلق «فاليرس» في نظرته لمفهوم الدولة في الشرق من الآليات نفسها التي حكمت نشأتها في الغرب، تلك الآليات التي أُنتجت في سياق الصراعات الطبقية، وانتهت بتهديم بنى النظام القديم، وسيطرة العلاقات الرأسمالية بالكامل معزَّزة توحيد السوق، والمحصّلة الثقافية، وتكامل المؤسسات وانسجامها وتأطيرها عبر أجهزة متداخلة ومتكاملة. إنَّ مثل هذه الآليات غير متوافرة في الشرق العربي، وهذا ما جعل الدولة العربية في النظام الإقليمي العربي تعيش مأزق مشروعها الذي ما زال مفتوحًا على احتمالات شتى.
الدولة العربية والتحديات الصعبة
إنَّ أزمة الدولة العربية ليست مفصولة عن أزمة النظام الإقليمي العربي العام، بل هي في الواقع، إنعكاس لأزمة هذا النظام الذي أخذ بالتبلور والتشكّل منذ بداية انضواء كياناته السياسية – الدول – في إطار جامعة الدول العربية التي نشأت كمنظمة إقليمية العام 1945، والتي باتت تضم في عضويتها، حاليًا، إثنين وعشرين دولة أو كيانًا سياسيًا، هذا، مع ظهور دولة جديدة ناشئة، هي دولة جنوب السودان التي ولدت مؤخرًا معلنة انفصالها عن الدولة المركزية، التي لم تتضح هويتها العربية بعد.
ثمة تحديات كثيرة ضاغطة لازمت هذه الدولة، وأبقتها أسيرة العجز الوظيفي من جهة، وأمام تزايد انكشافها الاستراتيجي من جهة أخرى.
أما الاسباب الكامنة وراء تفاقم العجز الوظيفي للدولة العربية الحديثة فهي أسباب بنيوية تتعلق ببنية الدولة نفسها، وهي تتمثل بإشكاليات عديدة أبرزها أربع أساسية:
1- إشكالية الجغرافية السياسية
إنَّ الدولة، بما هي إطار السيادة على الأرض والناس والثروات، وبما هي حيّز عام لجميع مواطنيها، تمارس وظائفها، دونما أي تمييز، في التشريع والتمثيل والقضاء من خلال مؤسسات عامة مكرَّسة لإدارة الحياة الإقتصادية والاجتماعية للمجتمع، هذا النمط الوظيفي المؤسسي للدولة لم يتلاءم مع البيئة الثقافية العربية، ولم يسبق للفكر السياسي العربي أن أدخل الدولة في وعيه العام. فهناك من يزعم أنَّ الدولة هي نموذج مقصور على الغرب، وأنَّ مفهومها هو طارئ على العقل السياسي العربي الذي ظلَّ يجهل أبعاد الجغرافية السياسية، وكذلك الوظيفة المركزية للدولة زمنًا طويلاً. فعلى امتداد التاريخ العربي كانت النزعات العربية اللامركزية تعبِّر عن نفسها في نطاق مقاطعات شبه مستقلة، لم تلبث أن تحوّلت مع السيطرة الاستعمارية الأجنبية إلى كيانات سياسية منفصلة، لتعود لتظهر في المرحلة الإستقلالية في إطار جامعة الدول العربية، التي لم تكن، في الواقع، سوى تجميعًا للتجزئة المانعة لقيام الدولة- الأمة أو الدولة القومية على قاعدة التوحيد الشعبي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.
2- إشكالية الهوية
لما كانت الهوية، من منظور علم الاجتماع السياسي، عبارة عن متكوّن مركَّب من عناصر خمسة: الانتماء، الثقافة، التواصل، التكامل، التوحّد السياسي، فإنَّ هذا المفهوم لم يدخل في البناء التركيبي للهوية في مجتمع الدولة العربية الحديثة. فقد ظلّت بنية الهوية العربية، وما زالت، تعاني اختلالات عميقة، مزمنة تعود لقرون عديدة سابقة (مملوكية وعثمانية) أحدثت فرزًا إجتماعيًا بين العناصر السكانية على أساس مفهوم «الرعية». والرعية، بدورها، محكومة إلى ولاءات أولية ملِّية مذهبية وطائفية وعشائرية وعرقية ومناطقية. ومع قيام الكيانات السياسية الحديثة (الدول) ظلّت الرعية حالة مفهومية امتدادية عبَّرت عن نفسها من خلال سلوكات ثقافية وإجتماعية وسياسية، الأمر الذي حال، حتى الآن، دون قيام كتلة مجتمعية عربية متجانسة إجتماعًا وثقافة وفكرًا. فلم يخرج المشهد العربي في ظل الدولة الإستقلالية الحديثة التي ظهرت في أعقاب السيطرة العثمانية والغربية، عن كونه فسيفساء من القوميات والقبائل والعشائر والملل المذهبية والطائفية، كل ذلك في إطار من الانقسامية المجتمعية، وهي في الواقع، إنقسامية إجتماعية وثقافية لم تستطع الدولة الحديثة أن تتغلّب عليها من خلال قلب الانقسام إلى التوحّد على قاعدة الاندماج المجتمعي وقيام مجتمع الدولة المتجانس والمتماسك.
3- إشكالية الديمقراطية
إنه النمط النبوي الخليفي المخزون في ثقافة السلطة العربية. فعملية تجديد النخب الحاكمة وتداول السلطة عن طريق الانتخابات الشعبية إفساحًا في المجال أمام المشاركة الديمقراطية، هي عملية ما زالت خارج الممارسة السياسية في أقطار الوطن العربي حتى الآن.
إنَّ القيادة السياسية العربية التي عرفها النظام الإقليمي العربي ما زالت شديدة التأثّر بالشخصية الاعتبارية للزعيم القائد أو الرجل الخارق الذي ينفرد بخصوصية كاريزماتية تجعله يتسم بالبطولة والشجاعة، والإقتدار واجتراح المعجزات.
إنَّ العرب، على مدى تاريخهم، مهيؤون لمثل هذه الظاهرة النمطية في السلطة، وهي ظاهرة ثابتة وعامة بغض النظر عن الزمان والمكان. أما منشأ العناصر الأساسية لهذه النمطية فهو اجتماعي ثقافيّ يتمثل في عناصر أربعة(12): الشخصانية او الذاتية – الفردية – اللامؤسسية – الاستعدادية النفسية لتقبّل الحالة.
يشكّل النمط النبوي – الخليفي بمجموع عناصره وحركيته المخيال السياسي العربي، وهو بصفته خاصية للمجتمع، غير محصور في الممارسات السياسية للقيادات بل هو أيضًا متمثّل في ما يشكّل النظرية السياسية للقيادة في الثقافة العربية(13).
إشكالية العلاقة بين الدولة والسلطة
في المشهد العربي، ثمة إشكالية تاريخية حكمت علاقة السلطة بالدولة. فالسلطة الحاكمة وضعت نفسها فوق الدولة، وصادرت دورها، حتى باتت الدولة مؤسسة عامة ووظيفة ملكًا خاصًا لأهل السلطة.
إنَّ مقاربة سوسيولوجية للتركيب الاجتماعي لنخبة السلطة الحاكمة في غير دولة إستقلالية عربية ظهرت مع لحظة الخروج الأوروبي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تبرز سمات هذه النخبة بالآتي(14):
أ. نخبة تابعة ثقافيًا وإقتصاديًا وسياسيًا لدول الغرب الرأسمالي.
ب. نخبة تضم كبار ملاك الأرض الذين استأثروا بعلاقات إنتاج ريعية لمصلحة مكانتهم الاجتماعية – السياسية، وعلى حساب القوى المنتجة في الأرياف الزراعية. هذا بالاضافة إلى بعض التجار الذين انخرطوا في علاقات السوق الرأسمالي، وكانوا، بمعظمهم، من عائلات أرستقراطية إستقرت في المدن، لا سيما المدن – المركز، وكان لها حضورها التجاري في أسواقها الداخلية.
ج. مجتمع النخبة مركب عشائري، قبلي، عائلي، إثني وطائفي.
صعود النخبة العسكرية إلى الحكم بعد نكبة فلسطين 1948، وشيوع ظاهرة الانقلابات العسكرية بوصفها الاسلوب الأفعل لاختصار مسافة الوصول إلى السلطة.
لم تلبث نخبة السلطة الحاكمة أن وفَّرت المعطيات اللازمة والضرورية لتأسيس نظام سياسي يقود الدولة والمجتمع معًا. إستطاعت قوى السلطة العربية أن تضفي على هذا النظام السياسي، وعلى مدى العقود الستة الممتدّة بين مطالع النصف الثاني من القرن العشرين وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي (الحادي والعشرين)، مرتكزات أساسية للشرعية، أبرزها أربعة:
1. المرتكز الديني (تحالف بين النظام السياسي والمرجعيات الدينية...)
2. المرتكز العسكري (الجيش، المخابرات، فرق الحماية الخاصة...)
3. المشروع الاجتماعي الداخلي (الإصلاح، العدالة الاجتماعية، التنمية...)
4. الخطاب القومي الداعي إلى تحرير فلسطين بوصفها القضية القومية المركزية الضاغطة على العرب جميعًا.
مثلَّث الأزمات
بعد مرور أكثر من نصف قرن على قيام النظام السياسي المشار إليه، برز ما يمكن تسميته بـ مثلّث الأزمات: أزمة النظام، أزمة المجتمع وأزمة الدولة.
أولا: أزمة النظام
تمثّلت أزمة النظام الحاكم في غير قطر عربي بالآتي:
1. إخفاق في مشروعه الإصلاحي التنموي الداخلي.
2. إخفاق في خطابه القومي تجاه تحرير فلسطين وتجاه القضايا القومية الأخرى.
3. تحصّن النظام بطبقة رابعة في المجتمع هي طبقة النظام تجمعها علاقات قائمة على شبكة من المنافع الخدماتية والزبائنية. من مواصفات هذه الطبقة أنها تحوَّلت إلى طبقة ممتدة أفقيًا وعموديًا أي أنها طالت سائر الشرائح الاجتماعية.
4. تحوّل النظام إلى عصبية قرابية حاكمة (عشيرة، أسرة، طائفة، حزب)
5. سادت الأوتوقراطية الحاكمة بدل الديمقراطية عبر تداول السلطة واتساع حجم المشاركة.
6. سادت التوتاليتارية في سلوك النظام، بحيث أنه بات مستحيلاً عليه إحداث تغيّرات نوعية خشية منه من أن يفتح ذلك الطريق أمام نهايته.
ثانيا: أزمة المجتمع
أبرز مظاهر هذه الأزمة:
- إنسداد أفق الطبقة الوسطى التي يتوقّف على دورها تأمين التوازن في المجتمع من جهة، وضمانة تغيير الدولة والمجتمع وتطوّرهما على السواء من جهة أخرى.
- تهميش قوى المجتمع المدني (أحزاب، نقابات، هيئات، روابط، إنتخابات).
إتساع مساحة التهميش للشرائح الاجتماعية الدنيا، حيث ارتفعت معدّلات الفقر والأمية، والهجرة، والبطالة. فقد أظهرت أكثر من دراسة إحصائية أنَّ أكثر من %50 من السكان في البلاد العربية يحصلون على نصيب أقل من %20 من الدخل الوطني، بالمقابل هناك أقل من %20 من السكان يحصلون على نصيب أكثر من %50 من هذا الدخل.
ثالثا: أزمة الدولة
برز الانكشاف الاستراتيجي للدولة في النظام الإقليمي العربي بقوة خلال العشرية الأولى من القرن الحالي (القرن الحادي والعشرين)، وتمثّل وفق المستويات الستة الآتية:
1- إنكشاف الأمن الغذائي
يُسجّل لمعظم الدول العربية تمتعها بمساحات شاسعة من الأراضي إلا أنَّها غير مستثمرة زراعيًا إلى الحدّ الذي يستجيب لكفاية سكانها من الحاجات الغذائية، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي في أكثرية هذه الدول رهنًا بتلقي الواردات من الخارج. فالعام 2007 بلغت قيمة هذه الواردات نحو 28 مليار دولار؛ في حين لم تتجاوز الصادرات الغذائية أكثر من 8.3 مليار دولار. وهذا ما يدل على وجود فجوة واسعة في الميزان التجاري العربي في تجارة السلع الغذائية تقرب من نحو 20 مليار دولار العام 2007، والأمر الملفت هنا، هو أنَّ مجموعة الحبوب والدقيق تسهم وحدها بنحو %46 من الفجوة الغذائية مقابل %54 لباقي المنتجات الأخرى(15).
جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 أنَّ المنطقة العربية هي واحدة من منطقتين وحيدتين في العالم شهدتا ارتفاعًا في عدد ناقصي التغذية، أما الثانية فهي أفريقيا جنوب الصحراء. فقد تزايد عدد الجياع العرب من 19.8 إلى 25.5 مليون شخص في الفترة الممتدة بين العامين 1992 و2004، أي بزيادة وصلت إلى 5.7 مليون شخص(16) أي بمعدل سنوي حوالى نصف مليون جائع في السنة. وهذا الأمر إن دلَّ على شيء فإنما يدل على فشل السياسات التنموية للدول العربية، ولا سيما في مجال تأمين الأمن الغذائي.
2- الانكشاف السكاني
يُسجّل الأهمية الوازنة للكتلة السكانية في سائر الدول العربية وذلك لجهة:(17)
الحجم السكاني المتزايد بوتيرة مضاعفة كل ثلاثة عقود، فيما في البلدان المتقدِّمة يحدث التضاعف كل 116 سنة. العام 1970 كان عدد السكان الإجمالي في البلدان العربية 122 مليونًا، إرتفع إلى 312 مليونًا العام 2005، ومن المتوقّع أن يصل إلى 484 مليونًا العام 2025 وإلى 850 مليونًا العام 2050.
أ. معدّل الخصوبة العام 2006 بلغ 6.2 في الصومال، و5.6 في اليمن، و4.4 في كل من السودان والعراق، وأكثر من 2 في البلدان العربية الأخرى.
ب. التركيب العُمري تتوزعه ثلاث فئات:
• فئة أقل من 15 سنة %38
• فئة بين 15 و65 سنة %60
• فئة فوق 65 سنة %2
وهذا ما يدل على أنَّ المجتمعات العربية هي مجتمعات شابة تتسم بالدينامية والحيوية، في حين أنَّ المجتمعات الغربية هي مجتمعات الشيخوخة نظرًا إلى اتساع حجم الفئات العُمرية المسنَّة مقابل الفئات الشابة والصغيرة السنّ.
إلا أن الثروة البشرية العربية هي ثروة غير مستثمرة، وهذا ما تدل عليه مظاهر الانكشاف الآتية:
أ. معدلات الأمية للعام 2009 (18): في العراق وصل المعدل إلى 58.9 %، وارتفع عند النساء إلى 74.8 %، المغرب 41.1 %، موريتانيا 37.5 %، السودان 36.9 %، مصر 33.6 % ، جيبوتي 29.7 %، الجزائر 24.6 %، تونس 19.4 %، عُمان 15.6 %، سوريا 15.5 %.
منقول
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة طلال العكيلي في المنتدى منتدى العشائر والقبائل العربية
مشاركات: 8
آخر مشاركة: 10-16-2022, 10:22 AM
-
بواسطة rss_net في المنتدى منتدى اخر مواضيع شبكة عراق الخير
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-13-2020, 02:53 PM
-
بواسطة عامر العمار في المنتدى مكتبة الادب والثقافة وعلوم اللغة والتربية
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 11-09-2015, 08:31 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
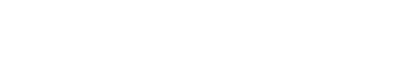








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات